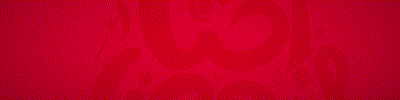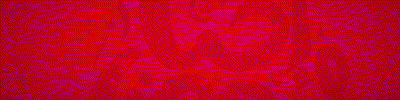الأزمة المالية العميقة للسلطة الفلسطينية وتحديات البقاء
نبهان خريشة

نبهان خريشة
في تصريحه بأن "حلول الأرض انتهت"، لم يكن وزير المالية الفلسطيني أسطفان سلامه يطلق عبارة إنشائية أو توصيفا عابرا لأزمة عابرة، بل كان يعلن عمليا وصول الوضع المالي للسلطة الفلسطينية إلى مرحلة العجز الكامل عن الاستمرار بالآليات التقليدية التي اعتمدت عليها طوال العقود الماضية. هذا التصريح، الذي جاء مترافقا مع تسريبات تفيد بعدم قدرة حكومة محمد مصطفى على دفع رواتب الموظفين عن هذا الشهر، يضع المشهد الفلسطيني أمام اختبار بالغ الحساسية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، حيث تتضاعف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على مئات آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الرواتب الحكومية.
السلطة الفلسطينية تعاني منذ سنوات من أزمة مالية مزمنة، لكنها دخلت خلال العامين الأخيرين مرحلة أكثر خطورة، انتقلت فيها الأزمة من كونها عجزا يمكن إدارته عبر القروض قصيرة الأجل أو تأجيل الالتزامات، إلى أزمة سيولة حادة تهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بأبسط التزاماتها. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى طبيعة هيكل الإيرادات الفلسطينية، حيث تعتمد السلطة بشكل شبه كلي على ما يعرف بعائدات المقاصة، وهي الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها على السلع المستوردة ثم تحولها شهريا. تاريخيا، شكّلت هذه العائدات ما بين 60 إلى 70 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، ما يجعل أي خلل في تحويلها كفيلًا بشل المالية العامة بالكامل.
ومنذ سنوات، تحتجز إسرائيل مبالغ كبيرة من أموال المقاصة، وتفرض اقتطاعات متراكمة بذريعة ديون أو التزامات سياسية وأمنية، ما أدى إلى تراكم مبالغ محتجزة تقدر بمليارات الشواقل. وتشير تقديرات مالية فلسطينية إلى أن إجمالي الأموال المحتجزة أو المقتطعة تجاوز خلال السنوات الأخيرة حاجز 10 مليارات شيقل، وهو رقم كفيل بتغطية رواتب الموظفين العموميين لأشهر طويلة. هذا الاحتجاز لا يقتصر أثره على بند الرواتب فحسب، بل ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على تسديد مستحقات الموردين، وتمويل القطاع الصحي، ودعم التعليم، وتشغيل البلديات والمؤسسات العامة.
في المقابل، تراجع الدعم الخارجي بشكل غير مسبوق. فالمنح والمساعدات التي كانت تشكل رافعة أساسية لسد العجز في الموازنة الفلسطينية تقلصت إلى حدها الأدنى، سواء بسبب التحولات السياسية الإقليمية، أو نتيجة اشتراطات المانحين، أو بفعل الإرهاق الدولي من نموذج تمويل سلطة بلا أفق سياسي واضح. في بعض السنوات السابقة، كانت المساعدات الخارجية تتجاوز مليار دولار سنويا، أما اليوم فهي لا تغطي سوى جزء محدود من فجوة العجز، وغالبا ما تكون موجهة لمشاريع محددة لا يمكن استخدامها لتغطية الرواتب أو النفقات الجارية.
تفاقم الأزمة يظهر بوضوح في بند الرواتب، الذي يعد أكبر بنود الإنفاق في الموازنة الفلسطينية. إذ يعمل في القطاع العام الفلسطيني نحو 170 ألف موظف مدني وعسكري، وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية ما يزيد على 600 مليون شيقل، وترتفع إلى أكثر من مليار شيقل عند إضافة رواتب المتقاعدين ومخصصات أشباه الرواتب. وفي ظل غياب الإيرادات الكافية، لجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى صرف رواتب مجتزأة، تراوحت بين 60 و80 في المئة، مع وعود بتسديد المتبقي لاحقا، إلا أن استمرار هذا النهج أدى إلى تراكم مستحقات غير مدفوعة، واستنزاف قدرة الموظفين على التحمل، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القوة الشرائية.
الاقتصاد الفلسطيني نفسه لا يساعد على امتصاص الصدمة. فالقيود المفروضة على الحركة والتجارة، وتراجع النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، كلها عوامل قلصت القاعدة الضريبية المحلية، وحدّت من قدرة الحكومة على تعويض نقص المقاصة عبر الجباية الداخلية. ومع ارتفاع الدين العام إلى مستويات تقارب أو تتجاوز 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق بعض التقديرات، باتت السلطة عاجزة عن الاقتراض الداخلي دون تعريض النظام المصرفي لمخاطر إضافية.
في هذا السياق يصبح تصريح وزير المالية أشبه باعتراف رسمي بأن الخيارات التقليدية قد استنفدت. فالاقتراض من البنوك وصل إلى سقفه الأعلى، وتأجيل الرواتب لم يعد حلا مستداما، والمساعدات الخارجية غير مضمونة، فيما تواصل إسرائيل استخدام أموال الفلسطينيين كورقة ضغط سياسية. ومع اقتراب شهر رمضان، يزداد القلق من تداعيات اجتماعية مباشرة، إذ تعتمد مئات آلاف الأسر على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي، وأي توقف كامل عن الدفع قد يفتح الباب أمام موجة احتجاجات واضطرابات اجتماعية يصعب التحكم بمساراتها.
أمام هذا الواقع، تواجه السلطة الفلسطينية عدة سيناريوهات جميعها صعبة. السيناريو الأول يتمثل في استمرار الوضع القائم، أي بقاء احتجاز أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي، ما يعني عجزا شبه كامل عن دفع الرواتب، وتدهورا متسارعا في الخدمات العامة، وتآكلا إضافيا في ثقة الشارع بمؤسسات السلطة. هذا المسار يحمل في طياته مخاطر سياسية وأمنية، وقد يؤدي إلى حالة عدم استقرار واسعة في الضفة الغربية.
السيناريو الثاني يقوم على انفراج جزئي، عبر ضغوط دولية تؤدي إلى الإفراج عن جزء من أموال المقاصة، أو عبر منح طارئة من بعض الدول لسد فجوة الرواتب مؤقتًا. هذا الخيار قد يخفف حدة الأزمة على المدى القصير، لكنه لا يعالج جذورها، ويعيد إنتاج الأزمة نفسها بعد أشهر، طالما بقيت بنية الاقتصاد الفلسطيني رهينة لعوامل خارجية.
أما السيناريو الثالث، وهو الأصعب، فيتمثل في محاولة إحداث إصلاحات مالية وهيكلية عميقة، تشمل تقليص الإنفاق، وإعادة هيكلة الرواتب، وتعزيز الإيرادات المحلية، وربما إعادة تعريف دور السلطة ووظيفتها الاقتصادية. غير أن هذا المسار يصطدم بواقع سياسي معقد، وحدود سيادية خانقة، وغياب أفق اقتصادي مستقل، ما يجعله خيارًا نظريًا أكثر منه حلًا عمليًا في المدى المنظور.
لا يمكن قراءة تصريح "انتهت حلول الأرض" بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه السلطة الفلسطينية. إنه توصيف مكثف لأزمة لم تعد مالية فقط، بل باتت أزمة نموذج كامل يقوم على إدارة حياة شعب تحت الاحتلال دون امتلاك أدوات السيادة أو ضمانات الاستمرارية. ومع اقتراب رمضان، تتقاطع الأزمة المالية مع الحساسية الاجتماعية والدينية، ما يجعل الأسابيع المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة النظام السياسي الفلسطيني على الصمود، أو على الأقل تأجيل الانفجار، في انتظار حل لم يعد ممكنا على الأرض وحدها.