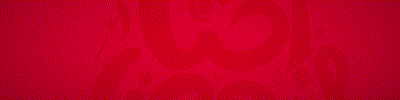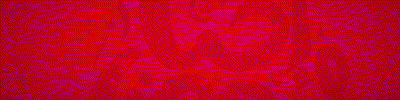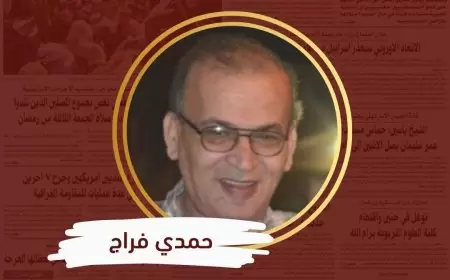الدستور الفلسطيني: من منطق الثورة إلى منطق الدولة

د. إبراهيم نعيرات
في اللحظات المفصلية من تاريخ الشعوب، لا يكون الحديث عن الدستور مجرد نقاش قانوني أو شكلي، بل يصبح سؤالًا عن شكل المستقبل ذاته، عن الهوية السياسية، وعن القدرة على إدارة الدولة حتى في أصعب الظروف. وفي الحالة الفلسطينية، يعود هذا السؤال اليوم بإلحاح غير مسبوق، كأنه محاولة لالتقاط لحظة سياسية هاربة بين الحرب والانقسام والبحث عن شرعية متجددة. منذ إقرار القانون الأساسي الفلسطيني عام 2003 وتعديله عام 2005، ظل هذا النص بمثابة دستور مؤقت ينظم عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، لكنه بقي إطارًا انتقاليًا أكثر منه عقدًا اجتماعيًا دائمًا، ومع تعطل المجلس التشريعي لسنوات طويلة وتوسع الحكم عبر القرارات بقوانين، بدأ الخلل البنيوي في العلاقة بين السلطات يظهر بوضوح، وبدأت الأسئلة تتكاثر حول من يملك القرار، ومن يراقب، ومن يحاسب، ولم يعد النقاش حول الدستور مسألة شكلية، بل أصبح مرتبطًا بجوهر النظام السياسي نفسه.
ثم جاءت التحولات الكبرى، لا سيما في قطاع غزة، لتضع النظام الفلسطيني أمام امتحان وجودي. الحديث عن “اليوم التالي” للحرب، عن إعادة الإعمار، وعن إدارة مرحلة سياسية وأمنية مختلفة، لا يمكن فصله عن الحاجة إلى مرجعية دستورية واضحة. فإعادة بناء الحجر لا تنفصل عن إعادة بناء الإطار الذي يحكم البشر. وفي ظل واقع منقسم منذ عام 2007 بين الضفة الغربية وغزة، لم يعد ممكنًا تجاهل أن هناك نظامين إداريين وقانونيين نشأ بحكم الأمر الواقع، وأي حديث جدي عن إنهاء الانقسام لا بد أن يمر عبر صياغة عقد سياسي جديد يعيد توحيد المؤسسات تحت مرجعية واحدة متفق عليها.
ولا يمكن تجاهل الأثر المباشر للحروب على الوعي الشعبي. فحرب غزة الأخيرة لم تكن مجرد صراع عسكري، بل كانت ضربة أيقظت الفكر الفلسطيني وكوته وعيه السياسي والاجتماعي، وجعلت الشارع أكثر إدراكًا لتناقضات السلطة بين منطق المقاومة المسلحة وضرورة بناء الدولة. هذه اللحظة أثبتت أن الشعب الفلسطيني لا يقبل بالحلول الجزئية أو المراوغة، وأن أي استمرار في نهج الصراع المسلح وحده قد يؤدي إلى المزيد من الانكسارات. في المقابل، تراها القيادة فرصة لإعادة النظر جذريًا في المنهج السياسي، نحو الابتعاد عن المقاومة المسلحة كخيار وحيد، وإعطاء طريق البديل—المقاومة السلمية وبناء المؤسسات الوطنية—فرصة واقعية لتثبيت شرعية الدولة وإعادة ترتيب النظام السياسي.
لكن المسألة لا تتعلق فقط بالانقسام الداخلي أو بتأثير الحروب على الشارع. فمنذ أن حصلت فلسطين عام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة, أخذ الخطاب السياسي الفلسطيني يتحدث بلغة الدولة أكثر من لغة السلطة. الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية عزز هذا التحول الرمزي والقانوني، لكن الدولة، في تعريفها الحديث، ليست مجرد اعتراف خارجي، بل هي أيضًا نظام دستوري داخلي يحدد شكل الحكم، وطبيعة النظام السياسي، وحدود الصلاحيات، وآليات تداول السلطة. هنا يصبح السؤال أكثر عمقًا: هل نحن أمام سلطة انتقالية مفتوحة الأمد، أم أمام دولة تحتاج إلى دستور دائم يعكس هويتها السياسية؟
في صلب هذا النقاش، تبرز مسألة الشرعية. المؤسسات المنتخبة تجاوزت مددها الدستورية منذ سنوات، والانتخابات العامة لم تُجرَ، وباتت الشرعية تستند أكثر إلى الواقع السياسي منها إلى صناديق الاقتراع. الدستور، في هذه اللحظة، يبدو كمدخل لإعادة تأسيس الشرعية على قاعدة واضحة: تحديد مدد الرئاسة والبرلمان، تنظيم الانتخابات، وضمان الفصل الحقيقي بين السلطات. إنه ليس مجرد نص قانوني، بل إطار يعيد تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
ومع ذلك، لا يخلو التوقيت من إشكاليات. فثمة من يرى أن الحديث عن دستور دائم في ظل استمرار الاحتلال هو قفز فوق حقيقة أن السيادة ما تزال منقوصة. كيف يمكن صياغة عقد دستوري كامل بينما الحدود والمعابر والمجال الجوي ليست تحت السيطرة الوطنية؟ وهناك من يعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للإغاثة وإعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار، لا لنقاشات دستورية قد تبدو نظرية في ظل واقع ميداني مضطرب. كما أن غياب توافق وطني شامل قد يحول أي مشروع دستور إلى ساحة صراع جديدة بدل أن يكون جسرًا للوحدة.
صحيح، ولا يمكن فهم لحظة النقاش الدستوري الفلسطيني دون إدراج العامل الإسرائيلي، وخصوصًا دور اليمين الإسرائيلي في توظيف التناقضات الداخلية الفلسطينية سياسيًا وأمنيًا. منذ سنوات، بنى اليمين في إسرائيل سرديته على مقولة أساسية: “لا يوجد شريك فلسطيني للسلام”. هذه المقولة لم تكن مجرد توصيف سياسي، بل أداة استراتيجية لإدارة الصراع بدل حله. ومع صعود حكومات يمينية متعاقبة، خصوصًا في عهد بنيامين نتنياهو، تحولت هذه السردية إلى إطار حاكم للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
استثمار التناقض الفلسطيني كان واضحًا. الانقسام بين الضفة وغزة، وازدواجية النهج بين بناء مؤسسات السلطة من جهة، واستمرار مظاهر المقاومة بأشكالها المختلفة من جهة أخرى، وفّرت لليمين الإسرائيلي مادة جاهزة لتعزيز خطابه أمام المجتمع الإسرائيلي والعالم. فالحجة كانت واضحة: إذا كان الفلسطينيون يريدون دولة، فعليهم أن يوحدوا قرارهم السياسي، ينزعوا سلاح الفصائل، يوقفوا كل أشكال المقاومة المسلحة، ويثبتوا عمليًا أنهم ملتزمون بمسار تفاوضي حصري. في المقابل، أي استمرار للعنف أو حتى الخطاب المزدوج كان يُستخدم كدليل على أن “النية الحقيقية” ليست السلام، بل إدارة صراع طويل الأمد.
بهذا المعنى، لعب اليمين الإسرائيلي على التناقض بين منطق الثورة ومنطق الدولة داخل التجربة الفلسطينية. فطالما ظل المشروع الفلسطيني يتحرك في منطقة رمادية بين التحرر الوطني وبناء الدولة، كان من السهل تسويقه إسرائيليًا ككيان غير مستقر، غير موحد، وغير قادر على الالتزام بتعهدات نهائية. ومن منظور إسرائيلي يميني، الثقة لا تُبنى عبر الخطاب السياسي، بل عبر السلوك الأمني الصارم. أي أن “الشريك” المقبول هو ذاك الذي يضبط الأرض أمنيًا، يمنع أي عمل مقاوم، ويُظهر قدرة كاملة على احتكار السلاح. لكن هنا تظهر المفارقة العميقة: الفلسطينيون يعيشون تحت احتلال مستمر، بينما يُطلب منهم في الوقت نفسه أن يتصرفوا كدولة ذات سيادة كاملة تضبط كل شيء. هذه معادلة غير متكافئة، إذ يُحمَّل الطرف الأضعف عبء إثبات الجدارة، في حين لا يُلزم الطرف الأقوى بتجميد الاستيطان أو إنهاء الوقائع الأحادية على الأرض.
في هذا السياق، يصبح النقاش الدستوري الفلسطيني جزءًا من معركة أوسع على السردية. فإذا اتجه الفلسطينيون نحو صياغة دستور يؤكد احتكار الدولة للسلاح، وضوح المرجعية السياسية، التزام آليات قانونية في إدارة الصراع، وتجديد الشرعية عبر الانتخابات، فإن ذلك يضعف حجة “لا يوجد شريك”، على الأقل في بعدها الشكلي والقانوني. لكن في المقابل، قد يرى البعض أن تحويل النظام السياسي بالكامل إلى نموذج “ضبط أمني” لإرضاء اليمين الإسرائيلي يحمل خطرًا آخر: فقدان التوازن الداخلي، وإضعاف الإجماع الوطني، وتحويل الدستور إلى أداة لتصفية الخلافات بدل تنظيمها.
المعضلة الفلسطينية هنا عميقة: إذا تمسكت بمنطق المقاومة، قيل إنها ليست شريكًا، وإذا ذهبت بعيدًا في منطق التهدئة والانضباط الأمني، قد تُتهم داخليًا بالتفريط أو المراهنة على مسار لم يحقق نتائج ملموسة منذ عقود. وهنا تتقاطع السياسة بالدستور. فالسؤال لم يعد فقط: ما شكل النظام السياسي؟ بل: ما تعريف المرحلة؟ هل هي مرحلة تحرر مفتوح؟ أم مرحلة تثبيت دولة قيد التشكل عبر أدوات قانونية ودبلوماسية؟
في هذا الإطار، كان إدراك القيادة الفلسطينية أن نهج المقاومة المسلحة، رغم شرعيته التاريخية، يُستغل سياسيًا وإعلاميًا من قبل إسرائيل، ويزيد من ضعف الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، لذلك دعا مرارًا إلى التحول نحو المقاومة السلمية. هذه الدعوة لم تكن مجرد خيار أخلاقي، بل أداة استراتيجية لحماية المشروع الوطني، وتعزيز الشرعية الدولية، وإتاحة مساحة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وترتيب العلاقة بين السلطات. المقاومة السلمية تمنح الفلسطينيين فرصة لتركيز الموارد والطاقة على بناء الدولة، صياغة الدستور، وتقوية مؤسسات السلطة، وفي الوقت نفسه تقليل الذريعة الإسرائيلية لاتهام الفلسطينيين بعدم الجدية في التفاوض أو عدم استعدادهم لشريك ثابت في السلام.
هذا التحول من منطق الثورة إلى منطق الدولة ليس سهلاً، فهو يتطلب تجاوز التناقضات بين الشرعية الثورية، التي تبرر الإجراءات الاستثنائية والمقاومة المسلحة، وبين الشرعية المؤسسية، التي تستلزم مؤسسات واضحة، قواعد حكم ثابتة، وآليات ديمقراطية.
الانتقال من شرعية الثورة إلى شرعية الدولة يعني إعادة صياغة المشروع الوطني ضمن إطار مؤسساتي دائم، دون التخلي عن جوهر النضال، ولكنه يفرض ضبط الصلاحيات، تنظيم الانتخابات، وإرساء قواعد واضحة لإدارة السلطة، حتى لا تصبح الاستثناءات مفتوحة قاعدة خطر على الدولة المستقبلية.
في هذا السياق، يصبح الدستور الفلسطيني أكثر من مجرد نص قانوني، فهو أداة لإعادة ضبط الساعة السياسية، لتقليل الفوضى، إدارة الانقسام، حماية المؤسسات، تأمين الشرعية، وإظهار قدرة الفلسطينيين على إدارة دولة حتى في ظل الاحتلال. هو إعلان بأن الصراع مستمر، لكن أدوات إدارته لم تعد ثورية فقط، بل مؤسساتية أيضًا. هو محاولة لخلق توازن بين الدفاع عن الحقوق الوطنية وبين الالتزام بآليات الدولة الحديثة، وهو لحظة تأسيس تعيد تعريف المشروع الوطني من زاوية مؤسساتية لا فقط نضالية. وفي ظل الصراعات الإقليمية، والانقسام الداخلي، واستغلال الجانب الإسرائيلي للتناقضات، يصبح النقاش حول الدستور الفلسطيني اليوم ليس رفاهًا فكريًا، بل ضرورة استراتيجية للبناء السياسي، وضمان شرعية المؤسسات، وإيجاد طريق فلسطيني متوازن بين المقاومة المشروعة وإمكانات الدولة الحديثة.
الدستور، في نهاية المطاف، ليس مجرد نصوص أو مواد قانونية، بل مرآة تعكس نضج التجربة السياسية الفلسطينية، إعلانًا بأن المشروع الوطني قادر على تجاوز الانقسامات الداخلية واستعادة وحدة القرار، وفي الوقت ذاته أداة مواجهة ذكية لاستغلال القوى الخارجية للتناقضات الداخلية، من أجل الحفاظ على المشروع الوطني، تعزيز شرعية الدولة، وتثبيت الأسس التي ستُمكّن الفلسطينيين من إدارة مستقبلهم بأنفسهم، حتى في ظل الظروف الصعبة للاحتلال والانقسام المستمر.