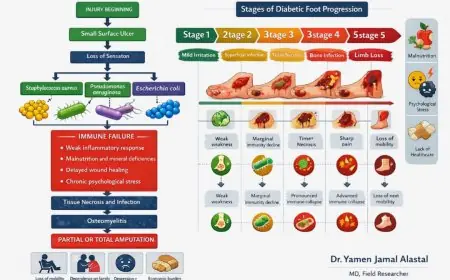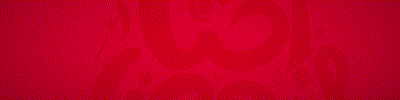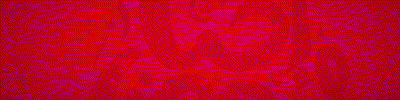نزار العيسة.. قصّاص أثر الدهشة والجمال

بهاء رحال
قبل السابع من أكتوبر، كان صديقي نزار العيسة يجوب البلاد طولًا وعرضًا، مسلطًا الضوء بكاميرته الخاصة على كل ما حوله من حجارة، وأماكن وزوايا، وطرق يتسلقها بين الجبال والتلال والوديان، يمشي مسافات من الود بقلب تغمره السعادة والدهشة، وبرغبة المستعد لاستكشاف المزيد من جمال البلاد، وقد بات الأمر سمَّة طبيعية من سمات الرحالة الباعث لصورة البلاد الجميلة، التي يسافر بنا إليها عبر مشاهد خاصة يلتقطها في جولاته، وكلما شاهدنا مقطعًا تصويريًا لدقيقة أو دقيقتين، اقتربنا أكثر من تلك الأماكن. كما بات نزار في عيون المتابعين له، مصدرَ معلومة موثقة بالصوت والصورة، حيث يحرص على جمع الحكايات من أفواه الجدات والأمهات، فبلادنا نبع حكايا لا ينضب، وتاريخها متدفق في جريان الود الموروث جيلًا بعد جيل، وهذا ما نلامسه كلما أخذنا العيسة معه في مسار جديد، بطابع خاص ومشاهد ترصدها مهارة يد تحرص على إيصال اللحظة بكامل أناقتها، وهذا ما نشاهده كلما رأيناه يمشي على قدمين تحملانه من دون تعب، فقلب المحب لا يتعب، فكيف وإن كان هذا الحب المتدفق في شرايين قلبه "لفلسطين".
يخرج العيسة في جولاته ومساراته بشكل طوعي، فقد استهوته البلاد التي أحب أن يراها عن قرب، كما يؤثر أن يجوب ما استطاع كمتتبع لأثر الأجداد وصوت الجدات، ففي كل جولة يخرج إليها مذاق خاص، واحد بروائح عطر المريمية، وآخر بنكهة الزعتر البري، ولا يضير الأمر حلاوةَ، مرارة اللوف، فالبلاد متعددة الحصاد في كل المواسم، ولكل موسم نكهته التي يتعرف منها الزائر على رائحة البلاد.
إذا زار حيفا، تراه يصعد إلى كرملها باسمًا، يطلّ من سفحه العالي على البلاد، وإذا عاد إلى قريته زكريا، فإنه يأوي إلى وادي الصرار الذي يحاذي البلادَ التي صارت خلفنا، ووقعت تحت الاحتلال إبّان النكبة الكبرى عام 1948، وبين حيفا وكرملها وزكريا وذكريات البلاد، يواصل العيسة مساراته على هَدْي السليقة حينًا، وعلى خُطى الأجداد أحيانًا، فلا تتوقف قدماه عن المسير، وهي تمشي في أزقة نابلس وسهول جنين، وبين يافا والجليل، والقدس ورام الله والخليل، وبين مدينة وأُخرى يرصد بكاميرته قرىً وأدوية وبيارق وأضرحة ومقامات الأولين الصالحين، وتراه بين الحين والآخر يعيد ترتيب خطواته، وكأنما يعيد ترتيب خارطة المكان في الزمان، فتلمس اهتمامه الكبير برصد كل ما يجده من حوله، بعناية فائقة كما لو أنه يتحسس أثر الفراشة، مؤمنًا بصدق ما قاله محمود درويش" أثر الفراشة لا يزول" .
من دون كلل أو ملل، بل بفرط من الرغبة والشوق والدهشة، يخرج نزار بمفرده أحيانًا، وفي أحيان أخرى ضمن جماعات من الأصدقاء والأصحاب، وفي دروب البلاد الطويلة والبعيدة، حيث يقطع مسافات شاقة، ليلتقط من خلال الكاميرا المحمولة في يده، وغالبًا ما تكون كاميرا هاتفه الشخصي، أو هاتف صديقه إبراهيم الذي يوثق كثيرًا، ويغيب اسمه أكثر، فيضحك الاثنان لأن الغاية من مقاطع الفيديو هي أن تصل للمشاهد، وأن يراها المتابع ويتعرف على بعض مفاصل الجمال المثير في بلادنا، وأن يروي ظمأ من منعه الاحتلال والظروف من الوصول، بل وأن يثيروا في نفوس الناس شغف الوصول والسير والمسير.
العيسة قصاص أثر الدهشة والجمال، إذ يقول دائمًا: هناك أشياء كثيرة لم أصل إليها رغم هذا التجوال الممتد كل ما مضى من سنوات، فبلادنا لا تكشف عن نفسها مرة واحدة، بل تدهشك، فكلما زرت قرية أو مدينة، تكشف لي سرًا جديدًا من أسرارها، وكلما مشيت أكثر عرفت أكثر، والتصقت بالتراب والتاريخ أكثر وأكثر. هكذا يزعم العيسة بأن الحب يجب أن يكون متبادلًا، وليس من طرف واحد، ولا يجوز الحب إلا بزيارة الحبيب لحبيبته، وأن يتعرف عليها وتراه قربها، فهذه فلسطين التي نحب، وعلى المحب واجب الزيارة.
سألته في اليومين الأخيرين: ما الذي يجعلك في خوف دائم وقلق؟ أجاب: أخاف ألّا أعود لتلك الزيارات، البوابات والجدار والقيود المستحيلة باتت تقف حاجزًا متينًا، وهذا ما يؤرقني بين الحين والآخر. وممّا تخاف أيضًا؟ سألته، فقال: من عبث الأغراب في تاريخ البلاد. ثم التفت إلى الجهة الأخرى قليلًا وابتسم، وأخفى عني سبب ابتسامته الخجولة الوادعة.
لأسباب كثيرة تعيشها البلاد في حقب زمنية وعقود من الوقت، يتوقف الرحالة عن مساراته، ويدخل في الصمت حيث هوايته تتعثر بظروف الواقع وإجراءات الاحتلال، فيختلف طقسه اليومي، وتتعطل دروبه محاطة بالحصار والجدار، وحديثًا بالبوابات الحديدية والأسلاك الشائكة، قاطعة الطريق في السهل والجبل.
توقف العيسة عن زياراته، بيد أنه يجرب بين الحين والآخر تحدي ظروف الواقع الخطير والصعب، وتجاوز العثرات ليصل أمكنة ليست بعيدة كما كان يفعل قبل السابع من أكتوبر، إلا أنه لم ينقطع تماماً، بل يواصل محاولاته في الوصول، فشغفه الدائم يدفعه للمحاولة، رغم ظروف البلاد المستحيلة، ورغم حالة الحصار المستمر الذي طال أمده، وبين وقت وآخر يأوي إلى ذاكرته التي جمعها خلال جولاته وترحاله، ويسهر معها طويلًا، كالساهر على الأطلال بفؤاده السائل عن الهوى.
لعل في الأمر بعض الأمنيات المؤجلة، فهو دائم التعلق بالأمل، وهو دائم الانتظار لفرصة تمنحه فسحة من الوقت، ليجوب البلاد ثانية ويسعى في دروبها، وتمامًا نحن مدينون لهذه الجولات التي نراها بالعين، وفي كثير من الأحيان لا نلمسها في الوقع، بيد أنها تدفع فينا الفضول، وتثير فينا الشغف، فقد ترانا نخرج إليها ذات يوم في مرافقة رحالة يجوب البلاد دون تعب