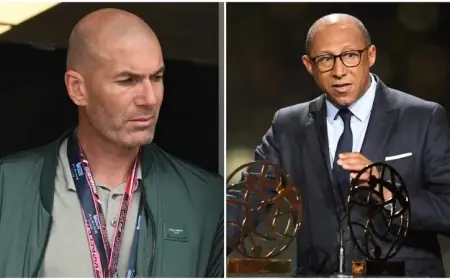أقف مع المعلّمين الفلسطينيين… حتى لا ينهار الوطن
بقلم: د. سماح جبر

بقلم: د. سماح جبر
منذ سنوات، يعيش المعلم الفلسطيني في الضفة الغربية تجربة أقسى مما يمكن أن يتحمله أي موظف أو مربٍّ للجيل. ليس لأنه يتقاضى راتبًا متواضعًا فحسب، بل لأنه يتقاضى نصف راتب، وبالتقسيط—مرّة في أول الشهر، ومرة بعده بأسابيع طويلة، من دون جدول زمني معروف، ومن دون وعد أكيد بأن نصف الشهر القادم سيأتي أصلًا. أصبحت مهنة التعليم، التي كانت يومًا عنوان الاستقرار في فلسطين، أقرب إلى مقامرة قاسية يعيش فيها المعلّم بين القلق والانتظار، وبين الشعور الدائم بأن الدولة التي يعلّم أبناءها لم تعد تقف خلفه.
في عملي، أرى انعكاسات هذا الوضع واضحة بشكل مُؤلم: معلمون يأتون محمّلين بأعباء تثقل كواهلهم، ينهكون في إعالة أسر ممتدة، يعتذرون لأبنائهم عن متطلبات لا يستطيعون دفع تكلفتها، ويراجعون حساباتهم كل ليلة ليقرروا أي فاتورة يدفعون وأي التزام يؤجّلون. هذا ليس ضغطًا اقتصاديًا فقط؛ إنه تآكلٌ بطيء لكرامة، وتحوّل تدريجي لمكانة المعلم من قدوة حسنة إلى عبرة للعيش على حافة الانهيار.
وهذا الوجع لا يخص المعلمين وحدهم، فقد أصبح عابرا للقطاع التعليمي وحاضرا في كل بيت. لقد أدّى نظام التعليم الجزئي—الذي صُمّم ليكون حلًا مؤقتًا—إلى ولادة واقع تعليمي هشّ: حصص تُلغى، وأيام دوام تُختصر، وطلاب يعودون إلى بيوتهم قبل إتمام منهج لم يعد أحد قادرًا على حمايته ويتفلتون إلى الشوارع. في الفصل الدراسي، لم يعد الطالب يرى معلّمه كمرجعية ثابتة، بل كإنسان مرهق، مشتت، يتنقّل بين الصف والوظيفة الإضافية، أو بين التعليم والعمل كأجير—وكل ذلك يُنتج صورة ذهنية سلبية وعميقة الأثر: المعلّم الذي كُسر قبل أن يستطيع تعليم أحد كيف يصمد.
والجميع يعرف أن المعلم الفلسطيني لم يبدأ هذا الحراك رغبة في التصعيد أو في تعطيل العام الدراسي. لقد حاول لسنوات أن يحافظ على جلده ومهنيته، وأن يدفع أثمان الأزمة من جيبه وصحته ووقته. لكن ما يحدث الآن تجاوز حدود التحمّل، وتحوّل إلى تهديد مباشر للبنية النفسية لأحد أهم أعمدة المجتمع. يكابد الفلسطيني صدمات الاحتلال، والحصار، والقتل، وهدم البيوت—لكن القليل منّا يفكر كيف يمكن لـ"سياسة الرواتب الجزئية" أن تُنتج شكلًا جديدًا من الظلم البنيوي: ظلم يجعل المواطن يشعر بأن جهده مُستباح، وأن مستقبله على المحك، وأن إنسانيته مهمشة.
إن تدهور الصحة النفسية للمعلمين ليس شأنهم وحدهم؛ إنه شكل من أشكال الإنهيار الجماعي. عندما يدخل المعلّم الصف وهو مُستنزف، يدخل الطلاب معه في دوامة الاستنزاف نفسها. وحين يشعر المعلم بأن الدولة لا تراه، ويطرد إذا رفع صوته مناديا بحقوقه، يتعلّم الطفل الدرس ذاته: أن الإخلاص لا يُكافأ، وأن الاجتهاد لا يضمن العيش الكريم، وأن الحقوق يمكن أن تُدار بعقلية الاسترضاء والإذعان، لا بعقلية العقد الاجتماعي.
ولا يمكن لأي مجتمع أن يدّعي الصمود بينما ينهار قطاع التعليم فيه. فالتعليم لا يؤجَّل لحين انتهاء الأزمة؛ بل هو خط الدفاع الذي تُبنى عليه قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات أصلًا. لذلك، حين يخرج المعلم الفلسطيني إلى الشارع مطالبًا براتبه الكامل، فهو لا يطالب بزيادة، ولا يبحث عن امتياز. إنه ببساطة يطالب بحقّه في البقاء واقفًا. يطالب بحدٍّ أدنى يسمح له بالاستمرار في دوره كحامل للوعي والمعرفة والتربية—في وطن يُصادَر فيه كل شيء، ويبقى التعليم أحد آخر مساحات المقاومة.
لقد تراكمت الأسباب، وتراكم معها ألمٌ اجتماعي صامت. ومع ذلك، ما زال بعض الخطاب الرسمي يتعامل مع المعلمين كأنهم عقبة، أو كأنهم يهدّدون "المصلحة العامة" بوقفتهم. الحقيقة هي العكس تمامًا: ما يهدّد المصلحة العامة هو استمرار تجاهل هذه المطالب، واستمرار سياسة أنصاف الحلول التي تترك أثرًا نفسيًا وتربويا طويل المدى لن يُمحى بسهولة.
إن الوقوف مع المعلمين اليوم هو واجب كل مواطن غيور على مصلحة الوطن، بل موقف أخلاقي وصحي وإنساني. وإنّ حماية كرامة وحقوق المعلم ضرورة لحماية مستقبل أطفالنا، وحماية جيلٍ كامل من أن يكبر وهو يتعلم
من تجاربه قبل كتبه أن الظلم مقبول، وأن الحقوق يمكن أن تتآكل بالتجزئة والتقسيط.
المعلمون الآن لا يدافعون عن أنفسهم وحدهم. إنهم يدافعون عن آخر ما تبقّى من النظام التربوي الفلسطيني، وعن قدرة مجتمع كامل على ألّا يفقد احترامه لذاته. وحين نؤيد حراكهم، فنحن لا نؤيد مطالب قطاع واحد، بل نؤيد حق أطفالنا في تعليم كريم، ومستقبل سوي، ونظام لا يبني شرعيته على صبر المظلومين.