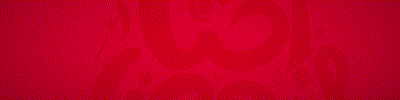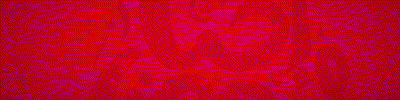الدفاع عن آلهةٍ مجروحة أيام الكبار في بيرزيت.. إلى مفيد عبد ربه

المتوكل طه
استيقظتُ على وجعٍ في الروح؛ إذ سمعتُ هاتفاً يتصادى نَعيُه، بأن أخاً لنا مناضلاً، قضى في الغربة، دون عزاء. إنه مفيد عبد ربّه، الذي كان أحد جذور البرقِ، ووَشماً ذهبياً طازجاً يفحُّ بِكُحْلِهِ في سماء مرحلةٍ رجراجة، في الأرض المحتلة، مع نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات. وأمعنتُ في صورة الخيال المنشرحة وتبأّرْتُ عينيه، فسطعَ كما كنتُ أراه وهو يذرع طرقات الحَرم القديم للجامعة، يغذّ الخطى نحو نجمة الفتح المتوهّجة الصاعدة.
منذُ قرنٍ لم نبرحْ بيتَ العزاء! وما يجري في غزة كافياً لأنْ يحتشدَ قلبُ الرجلِ ويموت! ولا أدري هل هذه الدنيا حياةٌ أم جنازةٌ؟ أم أملٌ فقيرٌ حتى تحينَ الحياةُ، وأعني تحت التراب؟ فَلنا الحزن، وليكنِ الماء المالح أو الحرف!
مفيد عبد ربه؛ شقيق عرّابي الحركة الوطنية، في وقت عصيب، تسقط فيه القلوب على الأقدام، أعني الذين خرجوا لتوّهم من المعتقل؛ أبو العزّ، حسن اشتيوى، وصنوه ورفيق دربِهِ أبو علي البوريني، وكان قبلهما نفرٌ مناضلٌ أرهص لحركة فتح في الجامعة، مثل الأخوة نبهان خريشة وسلام الصالح ورياض عويضة وجميل أبو سعدة وحسن أبو لبده وعبد الرحمن الشوملي وعدنان أبو حبسه، وهم عصبة حركية تناسلت من المعتقلات، ومعهم، كتفا بكتف، الأخوة محمد اشتية وعمر سمحة وجمال حسيبة والمرحومة إنعام صوفان ووجيه قشمر ورشاد حوراني وعنان الأتيري، وتبعهم نفرٌ نوعيّ كان أبرزهم الأخ المرحوم الجسور مفيد عبد ربه الذي تسنّم موقع رئيس مجلس الطلبة، تتويجاً لانسراب حركة فتح في صفوف طلبة الجامعة، وتجلّياً لتضحياتها وخطابها الوازن الموّار..
لقد تخرّجوا من المعتقلات الاحتلالية، وجاؤوا إلى جامعة بيرزيت يطلبون العلم، في وقتٍ كان فيه اليسارُ الفلسطيني الماركسيّ يسيطر تماماً على الحركة الطلابية في الجامعة، ولم يكن ثمة ذكرٌ بائنٌ لحركة فتح أو للحركة الإسلامية أو للأحزاب القومية.. وكان ذلك في العام 1978، ويبدو أن دخولَهم الحرم الجامعي القديم قد أحدث تغييراً دراماتيكياً في تركيبة الحركة الطلابية، حيث تمّ، وفي ظرفِ بضعة شهور، اصطفاف الفتحاويين المبعثرين، أو الذين لم يحسموا أمرهم من الطلبة الجدُد، ولم ينضموا بعدُ إلى هذه الكتلة أو تلك، فقد حُسم استقطابهم سريعاً إلى جماعة أبي علي وأبي العزّ.. وهكذا، تعالت فتح في بيرزيت، وانتقلت العدوى الحميدة إلى باقي المواقع في الضفة والقطاع.
مفيد عبد ربه كان معتقلاً مثل إخوته، وتحرّر، فانخرط ثانيةً في حمأة العمل الوطني، ولم يتردد وهو يشقّ أمواج الأرض المحتلة؛ نضالا وتنظيماً. مقدام، ناشط، شجاع، يروون عنه قصصاً استثنائية وهو في المعتقل، مثل كيف هجم على السجّان العنصري الفاشيّ العنيف، بِشفرةٍ أدمى بها وجهه، ما شكّل رادعاً لكفّ مخلب السجّانين عن الأسرى. ومفيد البسيط مثل عشب قاقون، متواضع لا يتفلسف، بعيد عن التعقيد والالتباس في كل منطوقه وسلوكه. كان الاحتلال يعيد اعتقاله مع إخوته من الجامعة، وكان يخرج، كأن قيداً لم يحبس ذراعه، أو يفتّ في عضده. كان منذوراً للفعل الوطني المبرّأ من الشبهة أو الغرض أو التشاوف أو المصلحة، وهذا ربما ما جعل الناس يصدّقونه، فانتخبوه عضواً في المجلس التشريعي، قبل أن تتناءى به المسافاتُ والمعطيات الصعبة، ويرحل إلى أمريكا ليموتَ غريباً شهيداً وحيداً هناك.
كان في الجامعات المحلية (النجاح الوطنية، بيت لحم، الخليل، المعاهد، وجامعات غزة) مجموعات تشبه مجموعة بير زيت، قوامها من خرّيجي المعتقلات، الذين قادوا العمل الحركيّ والوطني في الأرض المحتلة. هؤلاء الذين علّمونا أبجديات فتح وتاريخ حركات التحرّر، وأخذونا إلى المعرفة والانخراط بالعمل العام. وأنا هنا أُعلن امتناني التاريخي لهم، ولكل الإخوة الذين تذكّرتُهم أو لم أذكرهم، لأنهم أسّسوا الجبهة الطلابية الأكثر صلابةً ونفاذاً ومواجهةً للاحتلال، وكانوا، فيما بعد، مفجّري الانتفاضات العبقرية، التي شهدتها بلادنا بفخرٍ واعتزازٍ ومجد. وكلّ مَن ذكرتُ من الإخوة، وغيرهم، نماذج وطنية ووعي والتزام، شكّلوا معاً نسغ الحركة وجذعها الذي نبتت عليه غصون العمل الفتحاوي.
وبعد تخرّج تلك الأسماء، من بير زيت، مباشرة، وحتى انفجار الانتفاضة الكبرى، جاء الأخ مروان البرغوثي رئيساً لمجلس الطلبة، ومعه أسماء مضيئة حركية قائدة بدءاً من الأخوة سمير صبيحات ونايف سويطات ونزهت شاهين وأبو الأمجد علاونة، رحمه الله، وصولاً إلى يحيى السلقان وعمر الدمج وزكريا مصلح وجهاد أبو عين ومحمد المجذوبة وخالد اليازجي وصبري الطميزي وسمير ناصر وأديب أبو خليل وطارق الغول وخالد سليم وإبراهيم برهم ورشيد منصور وجمال إدريس وناصر أبو دلهوم وإبراهيم خريشة ومحمود النيرب وأحمد عيسى ورزق حمد وفهمي الزعارير.. وغيرهم. كانت بيرزيت عنوان الحركة الوطنية وسويداء قلبها، منها تخرُج المواقف الكبرى، وعنها يأخذ الشارع اتجاهاته.
بير زيت؛ جامعتنا الأولى التي ما زلنا أطفالَها الملكيين، الذين حملوا شوارعَ الصنوبرِ، طَمَعاً في تلك الغزالةِ، التي ما إنْ تَطَأ الأرضَ حتى ترتبكَ الدنيا ويكونَ الزلزال. والذين صهدتِ الحجارةُ بأكفّهم وتحت أقدامِهم اليافعةِ، في ليلٍ تقطَّرَ ناياً وانشراحاً ومواعيد نبيذٍ، مع قمرٍ ذاب على سطوح القرميد والشجر! كان في كلِّ ليلةٍ عُرْس، والجامعةَ أُسرةٌ واحدةٌ تلتحم بالغناء ليلاً، وفي التظاهر والنزيف والعرق والركض نهاراً، دون أن نغفلَ الدرسَ والمحاضرةَ والانكبابَ على البحث والإنصات للمعلمين، الذين كانوا يُشْبِهوننا في الجلوس حول طاولات الكفتيريا، يُناقشون ويختلفون ويدبكون ويتظاهرون. وأذكر باحترامٍ ذلك النشاط الذي كانت تقيمه دائرة اللغة العربية كل عام، وهو "سوق عكاظ الأدبي" للشِعر والقصّة والخطابة والمقالة، وكانت أسماء كبيرة هي التي تشكل لجنة التحكيم، من إميل حبيبي وسميح القاسم وعلي الخليلي وفدوى طوقان وأساتذة الأدب وغيرهم، ممَنْ كانوا يقلّدوننا الجوائز، ويعقّبون على ما نقدّمه من إبداع. لكن سوق عكاظ قد غاب، كما غاب "العُرْس الفلسطيني" السنوي للتراث والفنون، وغاب "أسبوع الجامعة الفلسطيني للمعروضات الوطنية"، وغابت "الفرقة الجامعية للمسرح" التي قامت بأداءِ غيرِ مسرحيةٍ للقاسم وعبد اللطيف عقل وسعد الله ونّوس وغارسيا لوركا وشكسبير وتوفيق الحكيم وغيرهم، وغابت "فرقة الدبكة الجامعية"، وغابت الجامعة التي نعرفها! ولطالما أقدمت قوّات الاحتلال على اقتحام الجامعة، أو على حرق الأسواق، أو على تخريب الفعاليات بإجراءات منعٍ وتقييدٍ واستباحةٍ واعتقال. لقد كانت مواسم تُنعش الروح والعقل والوجدان، وتحقّق التواصل بين المؤسسة والمجتمع، وتحيي التراث والذاكرة ومكوّنات الشخصية والهوية.
وإنْ أنسى، فلن أنسى أيام العمل التطوّعي! ونحن نشارك الناسَ القطاف، ونجلس معهم في البراري، وننام في المدرسة أو النادي، وثمة جدولٌ للاحتفال الليلي البهيج! أين ذهبتْ عذوبةُ وفحولة تلك الليالي والأيام؟
وما إنْ تدخلِ المقصفَ الجامعيّ حتى يُجَلّلُكَ الدخانُ والضوضاءُ، كأنكَ في خَليّةِ الأسطورةِ الساطعة، أو في حمأة آخِرِ المعاركِ الفاصلة، كأنّ المُتحدثين، من فتح أو الشعبيّة أو الديمقراطية أو الشيوعيين، يركبون أفراسَ المَعبد، وينافحون عن آلهةٍ مجروحة! إنه أُتونُ المرجلِ الذي صهرنا أربعةَ أعوامٍ سِماناً، فغدونا نمسكُ الريحَ، ونؤَوِّبُ مع أغانيها في الزنازينِ والعتباتِ البعيدةِ، وما فتِئنا نقفُ على أرضِ المقصفِ الراسخةِ، التي كشفت لنا عُمقَ سذاجتِنا وروعةَ فطرتِنا ورُعبَ ما في هذا الكونِ من جنونٍ وصوفيّةٍ وتأويلٍ وذهول.
وافتتحت جامعة بيرزيتُ النشيدَ! ولكن، وبعد أكثر من أربعةِ عقود، انقلبَ المشهدُ التراجيديُّ الصلبُ إلى كوميديا تشي برائحةِ الدم الحرام.. فكيفَ وصلْنا إلى هذا الوحلِ والضمورِ والتعويمِ والانفلات؟ وكيف نحتملُ الكلامَ الذي يشيعُ الأبيضَ الباهتَ دون أن تُصيبَنا القشعريرة، التي مسّت الحديدَ فمدَّ لسانَه على عجبٍ لا يُطاق؟ ولا جدوى من هذا الارتكاس الأنيقِ، أو التلهّي بهذه الذكريات العابقة، لأنَّ الحوذيَّ أتقنَ ضربَ السياطِ، وأصبحنا مدجّنين كما يروقُ لأمسياتهِ العارية، ولا بأسَ من أن نقضيَ ما تبقّى من أيامٍ، فقد ردَّد النقّادُ إطراءَهم وتبريراتِهم بإتقانٍ شديدٍ، ولن يُغطّي نُحَاسُ الصنّاجةِ أسماءَنا العاليات، أو ما يقوله الرواةُ في الخانِ، أو على جسرِ القمرِ الوحيد.
فليمُت مَنْ يمُت، ولينتحرْ مَنْ ينتحر، وليقدّمِ الأميرُ قبّتَنا الذهبيّةَ المعتّقة إلى سادنِ الجحيمِ الوحيدِ.. فماذا عسانا نفعلُ في هذا السقوطِ المخيفِ الواسعِ المجنونِ؟
بضعُ كلماتٍ ونردُم في العيونِ البسيطةِ كل هذا الرعب. وببضعِ كلماتٍ نُبشّرُ بالنشيدِ والصغارِ.. ونعرفُ أننا نمارسُ آلياتِ التعويض.. إلى حين ولادة الفارس الذي لا يموت.. وإلى حينها؛ عليك الرحمة وعلينا البكاء.
مفيد البسيط مثل عشب قاقون، متواضع لا يتفلسف، بعيد عن التعقيد والالتباس في كل منطوقه وسلوكه. كان الاحتلال يعيد اعتقاله مع إخوته من الجامعة، وكان يخرج، كأن قيداً لم يحبس ذراعه، أو يفتّ في عضده.