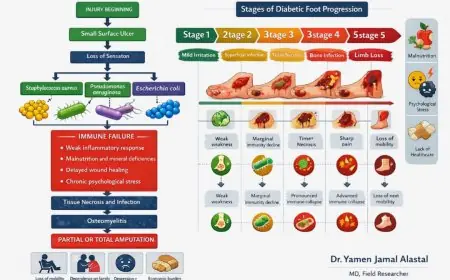سوريا بين مشروع الأمة ومشروع الإزاحة: كيف انكسرت الدولة من صلابة الأسد إلى هشاشة الجغرافيا؟
جمال رفيق العبادي- باحث دكتوراة في العلاقات الدولية

جمال رفيق العبادي- باحث دكتوراة في العلاقات الدولية
من الصعب الحديث عن سوريا دون استحضار تلك الثنائية التي رافقت تاريخها منذ منتصف القرن الماضي: دولة تسعى إلى تعريف ذاتها من جديد، وجغرافيا تُقاوم أن تكون ساحةً بين الآخرين. لم تكن دمشق يومًا عاصمة تقبل أن تُدار من خلف البحار، ولا أن تكون نقطة عبور في خرائط الآخرين. ومنذ الستينيات، لم يكن الصراع على السلطة في سوريا صراعًا محليًا بمقدار ما كان صراعًا على موقع سوريا في الشرق الأوسط: هل تقف في قلب مشروع الأمة، أم تُدفع إلى هوامش الدور والمكانة؟ هل تكون رأسًا في مواجهة إسرائيل، أم مجرد دولة محايدة تتعايش مع الإقليم كما هو؟ هذا السؤال، لا غيره، هو الذي صنع المسار السوري بأكمله، ودفع القوى الكبرى لأن تتعامل مع سوريا بوصفها “عقدة يجب حلّها”، لا بوصفها دولة فقط.
حين نبدأ من عام 1963، فإننا لا نستعيد مجرد حدث سياسي، بل نستعيد نقطة انعطاف أنهت حقبة الفوضى التي تلت انفصال 1961 وافتقار سوريا لهوية سياسية واضحة. كانت البلاد موزعة بين نخَب متنافسة، جيش مُسيَّس، أرياف مهمَّشة، ومدينة تبحث عن نمط تمثيل سياسي يضمن لها الاستقرار. كان الفراغ كبيرًا، وكانت المنطقة كلّها في حالة غليان: مصر في ذروة مشروعها الناصري، العراق يترنّح بين انقلابات، الأردن في وضع هش، ولبنان على شفا انفجار. في تلك اللحظة، تحرك البعثيون بدعم شبكات داخل الجيش ليضعوا نهاية لمرحلة ويبدأوا أخرى.
لم يكن انقلاب 1963 مجرد استيلاء على السلطة، بل كان محاولة لصياغة “عقيدة دولة”. كانت سوريا تعيش إحساسًا بالانكسار بعد فشل الوحدة مع مصر، وكان المزاج العربي كله يبحث عن مشروع جديد يعيد تعريف الأمة. جاءت البعثية إذن كحامل لثلاثة وعود: العدالة الاجتماعية، بناء دولة قوية، وموقع عربي في مواجهة إسرائيل. لكن الواقع كان أكثر تعقيدًا من الشعارات، فسرعان ما بدأ التناقض بين طموح الحزب وضعف أدوات الدولة، بين الخطاب القومي وأزمة النمو، بين السلطة التي تتشكل والبيئة السياسية المتفككة.
لم تكن سوريا بعد 1963 قد أصبحت دولة مستقرة بعد. كانت هناك صراعات داخل الحزب، تنافس داخل الجيش، ومحاولات لا تنتهي لإعادة تشكيل مراكز القوة. ومن رحم تلك الفوضى، ظهر اسم حافظ الأسد—ضابط شاب، صامت، دقيق، فهم مبكرًا أن الدولة لا تُبنى بالخطابة، وأن الجغرافيا لا تُدار بالشعارات. أدرك أن سوريا، بجغرافيتها وكونها الدولة العربية الأقرب جغرافيًا إلى فلسطين، لا يمكنها أن تكون “دولة عادية”. كانت الحدود مع إسرائيل وحدها كافية لفرض طبيعة سياسية مختلفة، وكانت علاقتها بلبنان والعراق والأردن تجعلها في قلب كل حركة سياسية أو عسكرية في المنطقة.
عام 1970، حين قام الأسد بحركته التصحيحية، كانت البلاد قد وصلت إلى نقطة اللاعودة: جيش مُنهك، مؤسسات مترهلة، واقتصاد لا يلبّي احتياجات السكان. ورغم ذلك، كانت سوريا تمتلك شيئًا لم تمتلكه دول عربية أخرى: روحًا عامة تميل للتحرر الوطني، وشعورًا لدى قطاعات واسعة بأن الدولة ليست مجرد جهاز، بل مشروع أكبر. جاء الأسد وهو يدرك أن السوريين يبحثون عن “دولة تُشبههم”، لا دولة تُشبه صراعات النخب. ومن هنا بدأ مشروعه.
كان تحوّل حافظ الأسد أكبر من كونه توسعًا في صلاحيات الرئيس. لقد أرسى رؤية تقول إن “سوريا ليست دولة صغيرة”، بل دولة مركز إقليمي، وأن استقرارها الداخلي مرتبط بدورها الخارجي، وأن علاقتها بالعروبة ليست خيارًا بل إطارًا. لهذا استثمر في الجيش، وفي مؤسسات الدولة، وفي بناء بيروقراطية قادرة، وفي خلق شبكة تحالفات عربية تبحث عن توازن أمام إسرائيل والغرب. لم تكن تلك شبكة مثالية، وربما كانت مشوبة بالخشونة السياسية وغياب المرونة، لكنها أعادت لسوريا دورًا كانت قد خسرته بعد الانفصال: دور الدولة التي يمرّ عبرها كل شيء، والتي لا يمكن تجاوزها.
في تلك المرحلة، كان الغرب ينظر إلى سوريا بوصفها “مشكلة استراتيجية”. دولة راسخة في خطاب العداء لإسرائيل، متحالفة مع الاتحاد السوفييتي، مؤثرة في لبنان وفلسطين والأردن، وممسكة بجغرافيا تعطل أي مشروع غربي لشرق أوسط ليبرالي أو مستقر على أسس مصالحه. لم تكن الإشكالية في الأسد كشخص، بل في “الأسدية” كفكرة: دولة مركزية قوية، ذات خطاب قومي، قادرة على التأثير الإقليمي. هنا بدأ التوتر بين سوريا والغرب يأخذ شكلًا بنيويًا: سوريا ليست دولة يمكن احتواؤها بسهولة، وليست دولة قابلة للتطويع، وليست دولة تبحث عن اعتراف خارجي بقدر ما تبحث عن توازن داخلي–خارجي يعزز قوتها.
ومع دخول الثمانينيات، تعمّقت معادلة سوريا: دولة تعاني من ضغوط اقتصادية، لكنها تتوسع سياسيًا في لبنان، وتدعم فصائل المقاومة، وتواجه مشاريع أمريكية–إسرائيلية لإعادة هندسة المنطقة. كانت دمشق تدرك أن قوتها ليست في اقتصادها، بل في موقعها ودورها: دولة حدودية مع إسرائيل، متصلة بالعراق والأردن ولبنان، ومؤثرة في فلسطين. ما جعل سوريا “عقبة” أمام كل المشاريع الغربية منذ حرب 1973، مرورًا بحرب لبنان، وصولًا إلى فترة ما بعد الحرب الباردة.
حين وصل بشار الأسد إلى الحكم عام 2000، كان يرث دولة قوية سياسيًا، لكنها مُتعَبة اقتصاديًا ومثقَلة بإرث عقود من المواجهات الإقليمية. كان أمامه خياران: الانفتاح على الغرب وتخفيف التوترات، أو الحفاظ على الموقع القومي لسوريا مع إدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية تدريجية. حاول الجمع بين الاثنين، لكن الواقع الإقليمي لم يساعده: غزو العراق 2003 قلب الموازين كلها، ووضع سوريا بين خيارين: إما أن تخضع للنظام الأمريكي الجديد، وإما أن تصبح هدفًا لمحاولات الإزاحة. اختارت دمشق الخيار الثاني، فبدأت الضغوط. وجاء القرار الأمريكي–البريطاني بتبني خطاب “محاسبة سوريا” بعد 2005 كجزء من محاولة لقصّ أذرعها الإقليمية ودفعها للخروج من لبنان وتطويق تأثيرها على المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
هذا لا يعني أن الداخل السوري كان مثاليًا. بل على العكس، كانت هناك أزمات بنيوية: اقتصاد متعب، غياب إصلاح حقيقي، جهاز دولة بدأ يفقد حساسيته تجاه الشارع، وبيروقراطية لم تعد قادرة على التجديد. لكن هذه الأزمات لم تكن كافية وحدها لتفسير ما حدث لاحقًا. ما فجّر الوضع لم يكن فقط غضبًا داخليًا، بل “تطابق ظرفين”: ظرف داخلي هش، وظرف خارجي يرى أن لحظة إزاحة سوريا من موقعها التاريخي قد حانت.
وحين اندلعت الأزمة عام 2011، كانت سوريا أمام أكبر موجة استهداف جيوسياسي منذ منتصف القرن الماضي. لم يكن الأمر مجرد احتجاجات، بل تحولًا هائلًا في مقاربة الغرب لسوريا: من دولة صعبة إلى دولة يجب تفكيكها. هنا بدأ الصراع الحقيقي: لم تعد سوريا تقاتل لأجل النظام، بل لأجل الدولة نفسها. وهذا ما يفسّر لماذا تحولت الأزمة إلى حرب، ولماذا دخل الإقليم كله على الخط: تركيا، الخليج، الغرب، روسيا، إيران… الجميع كان يرى في سوريا أكثر من مجرد ساحة. كانت “عقدة الشرق الأوسط”، ومن يسيطر عليها يعيد ترتيب المنطقة بأكملها.
لكن السنوات اللاحقة كشفت شيئًا مرًّا: الدولة التي كانت يومًا “عقدة قوة” أصبحت شيئًا آخر. تحولت من دولة المبادرة إلى دولة النجاة. من دولة تصنع محيطها إلى دولة يحاصرها محيطها. من لاعب إقليمي إلى ساحة تتقاسمها القوى. ليس لأن مشروع سوريا القومي كان خاطئًا، بل لأنه لم يجد ما يكفي من التجديد الداخلي ليحافظ على صلابته، ولأن الإقليم دخل مرحلة من الفوضى جعلت كل الدول مهددة. ما حدث في العراق، وما حدث في لبنان، وما حدث في فلسطين، كان يؤشر إلى انهيار المنظومة الإقليمية بأكملها، وسوريا لم تكن قادرة على النجاة وحدها.
واليوم، حين ننظر إلى سوريا في عام 2023 وما بعده، نرى دولة تغير موقعها من مركز المبادرة إلى هامش متعب. نرى دولة تحتاج إلى إعادة بناء ليس على مستوى العمران فقط، بل على مستوى الفكرة. هل تبقى سوريا دولة عربية قومية؟ هل تعود إلى دورها في مشروع المقاومة؟ هل تستطيع تجاوز الانقسامات والحدود الجديدة التي فرضتها الحرب؟ هذه أسئلة مفتوحة، لكن ما هو مؤكد أن سوريا لا تزال—رغم كل شيء—ذات معنى استراتيجي لا يمكن تجاوزه. جغرافيتها لا تزال تفرض دورًا، وتاريخها لا يزال يمنحها هوية، وشعبها—رغم كل ما مرّ به—لا يزال يرى في سوريا أكثر من دولة: يرى فيها فكرة.
ولعل الخلاصة الأهم اليوم هي أن سوريا لم تسقط لأنها دولة قمعية كما يقول الغرب، ولا لأنه كان فيها نظام غير ديمقراطي، فهذه السمات موجودة في عشرات الأنظمة ولم تُمسّ. سوريا استُهدفت لأنها كانت “دولة ذات معنى”، لأنها كانت جزءًا من مشروع أكبر من ذاتها، لأنها كانت عقدة في وجه مشروع إقليمي ودولي أراد شرقًا أوسط جديدًا بلا جغرافيا مقاوِمة، بلا عواصم تعطل مسار التطبيع، وبلا دول ترى في فلسطين جزءًا من أمنها القومي.