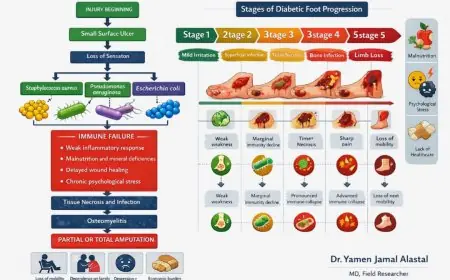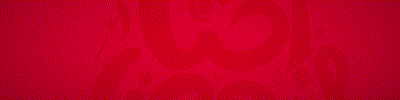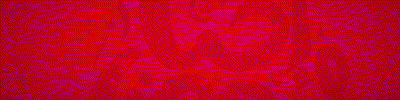معتصم العلي، وعلي الفوده، وجهان لقمر واحد

الكاتب: برهان السعدي
من أجل الأمانة العلمية، وحفظ حق الملكية الفكرية، وصلتني هذه المقالة مروسة باسم كاتبها: "خيال عصوم النور شمسي" ، أو قل هذه الخاطرة، فلروعة أسلوبها الأدبي، وسلاسة تسلسل ما ترمي إليه، ولما تحمله من مقاربة بين عملاقين، رأيت أن من حق كل مثقف وكاتب، ومن حق ذوي الاهتمام، ومن حق المتذوقين للأدب، ومن حق الكاتب أيضا أن يصل هذا الإنتاج الإبداعي الجميل، الذي وقفت عنده كثيرا، فهل أنا أمام لوحة فنية، أم أمام قصيدة شعر، أم خواطر تترى بهذا الإيحاء وجمال النفس وعظمة العطاء، أم أمام مقالة فكرية سياسية، أم هي خلطة الإبداعي بأسلوب سحري يجعلك في متاهة التصنيف. فأنقل للقارئ مقالة كاتبها، باسم زخرفي جميل، يحمل جدلية الشمس، ليولد أسمى معاني الحب والتضحية والعطاء: "معتصم العلي، وعلي الفوده، وجهان لقمر واحد"
لن نَمَلّ الكتابة عن اسطورة قلّ نظيرها، ولن نَكِلَّ وصف بطولةٍ عَزَّ مثيلها، ولن تخبو فينا جذوة الاستعداد لتصوير لوحة تعبيرية رائعة، مزجت الوانها ريشة فدائي مقاوم، وحدد معالمها قَسَمُ الأطهار و وفاء الاحرار، برؤيا صادقة، وحقيقة نابضة، عكست جوهر "عصوم " الفلسطيني العنيد ، الذي نشأ راسخ الايمان، وشبَّ ثابت القلب، ونَهَل علوم الحرية، والتضحية والانعتاق، من إرث أستاذ الفقه الثوري الافتراضي "علي فوده" ، مؤسس مدرسه " الرصيف " البيروتية العريقة، المدعومة بفلسفة التحدي، المعمدة بالمذهب الرافض، والفكر المقاوم. فاستحق "المعتصم" وعن جدارة شهادتها العليا، كأحد خريجيها المبدعين والمتفوقين.
فسطع وهج الشَّبَهِ بين الاستاذ الغجري، وتلميذه المتألق العنيد. كلاهما اتقن فنون التمرد على ضفاف الزومر في مخيم نور الشمس، مخيم العزة، بوتقة الوحدة، عرين الشدة، جسر العودة. بينهما توارد خواطر، وترابط افكار، وتخاطب ونجوى، رغم استشهاد علي، قبل ميلاد المعتصم بعقود.
كل منهما قبض على الجمر في زمن الردة، والانكفاء والخذلان، وكلاهما تعرض لنفس المصير المؤلم، على يد ذات القاتل المجرم، لكن في مكانين وزمانين مختلفين. فالشهيد "علي فوده" الذي خطفت أحلامه عصابات الإرهاب الصهيوني إبّان النكبة، لاحقته طائرات الاحتلال الغاشم الى بيروت لتطفيء حياته في أوج شبابه، وذروة عطائه، وتالق أشعاره.
وكان "المعتصم" قد حفظ عن ظهر قلب ترانيم أبيات قصيدٍ لم يسمعها، في دواوين شعر "علي" دون ان يقرأها، او يعرف شيئاً عنها، او عن ناظمها. وترجم معانيها، - قبل ان يعيها او يدرك مغزاها- إلى مواقف ثابتة، وممارسة فعلية دائمة، فأعلن جهاراً نهاراً، عياناً بياناً، -على وحي مفاهيمها، وعلى هدي وصاياها-، عن نيته الالتحام والاتحاد جسداً وروحاً مع تراب الوطن فلسطين – "حباً وطواعية" -، ليبقى قلبه - "دائم الخضرة، دائم الثورة" - واثق الخطوة، ضاحكاً، متهللاً "وان بان في عينيه الأسى" -، فتحققت امنيته بالخلود شهيداً، محلقاً فوق ذرى المجد - "سراً وعلانية"-، فنقش تقاسيم وجهه عميقاً في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، ورسم بفلسفة الرفض والتحدي، معالم درب العزة، والشموخ والإباء، لقوافل الثوار العائدين، الذين حفظوا تفاصيل ضحكة "عصوم" ومكامن غضبه، وبرعوا في استخراج الحِكَمَ الثورية من ايماءاته التي ملأت الأرجاء ثورة وصخباً، - "رشاش عنف وغضب". فتطابقت الاوصاف، وتماثل الشَّبه، وتناظرت الصفات بين "المعتصم علي"، وبين "علي الفوده" الذي شدى في عشق الوطن بإحدى روائعه:
إني اخترُتك يا وطني
حُبّا وطواعية
إني اخترتك يا وطني
سِراً وعلانية
إني اخترتك يا وطني
فليتنكّر لي زمني
ما دُمْتَ ستذكُرني
يا وطني الرائع يا وطني
دائمُ الخضرة يا قلبي
وإن بان بعَيْنَيَّ الأسى
دائمُ الثورةِ يا قلبي
وإن صارت صباحاتي مَسا
جئتُ في زمن الجزْرِ
جئت في عز التعب
رشاش عنف وغضب
كما هو حال "علي"، توقع "المعتصم" الموت شهيداً، وشعر دنو الأجل القريب. وأيقن انه سوف يقاوم صلف الاعداء، ويكافح إرهاب الاحتلال، بين تَجاهُل أزيز الرصاص، وتَحمُّل وجع الشظايا، وأدرك مبكراً اننا شعب لا يموت. وهكذا، راضياً مستبشرا قضى، وبلا صخب ترجًّل، وبهدوء مضى، فاستحق وعن جدارة ان يكافأه رب العزة بالحياة الخالدة، فالاستسلام لم يكن ضمن حساباته أو جزءً من خياراته،
وكتب مخاطبا أحد اصدقائه قائلاً:
" برحمة أبوي ، حاسس كتير، أربع خمس أيام، أكون ميِّت، بشرفي حابب اشبع منكم، مش أكثر". وكتب في رسالة اخرى: " الاستسلام مش النا".
بنفس الاسلوب، وعلى ذات الطريق، توقع "علي" دنو موعد استشهاده، حين قال:
وأهتف باسم فلسطين،
هذا دمي للورد أسفحه وأمضي،
لست أخشى طلقة القناص،
ليس يميتني هذا الرصاص
ولست أرهب قاتلي
لكن قلبي على وطن يعشش في شراييني فكيف أموت؟
أنا الحجر الفلسطيني يا بيروت!
ومع اشتداد هجمات الاحتلال الارهابية على المخيم وتحديدا حارة " الدمج"، ساور الخوف قلب المعتصم على مصير رفاقه، وسعى قبل الاستشهاد لتأمين معيشتهم، وضمان استمرار كفاحهم، وكأنه طلب مهلة من الله تعالى لأن يفي بالتزاماته اتجاه رفاقه قبل وفاته، فكتب بأحد منشوراته:
"خايف اروح وانا مش مجهّز أمور اللي معي. ويضلوا برقبتي"، "لازم أءمنهم قبل كل شيء". "والله لو تيجي علي، كنت قبل ولا فارقه اشي معي، بس هسه الوضع اتغير، صرت اعمل حساب للي معي، وأفكر باللي معي أكثر من حالي".
وهكذا كان حال "علي" الذي ارتوى من كأس الغدر والطعن بالظهر والخذلان، يطلب هو الاخر مهلة زمنية لوداع سهول فلسطين، حين قال في إحدى قصائده:
أمهلوني قليلاً .. ألا تستطيعونْ؟ !
مُصّوا دمي ..
إنّما قطرةً قطرةً
علّني أشهد البرق وهو يُغنّي
بمرج ابن عامرَ أو في الجليلْ
بعدها ..
فلأكنْ أوّل الشهداء وآخرهم
ولأمتْ في البراري قتيلْ !
لم يطل الانتظار "بالمعتصم" طويلا حتى أتمَّ واجباته، وأنجز فرائضه، واستعد لتلبية نداء ربه، مقبلا غير مدبراً، معلناً الاستعداد للاستشهاد، والاستمتاع بالحياة الخالدة، حيث خاطب مجموعة الرفاق بتعميمٍ مقتضبٍ قائلا :
إننا فوضنا امرنا لله، إما النصر، أو الشهادة في سبيل الله".
في ذات المضمون، تحدث "علي" عن طريقة موته، وتوقع ان يرقد في بركة دم، وطلب من كل من يعرفه ان يتذكره، ولم ينسَ التأكيد على عشقه لفلسطين، فقضى نحبه ليمتطي ذروة المجد مُبدعاً، وسنام الخلود شامخاً، حيث أنشد قائلاَ:
من يعرفني حقاً
لا بدّ سيذكرني يوماً
فيقول.. كان هنا حياً بالأمس
وها هو يرقد في بركة دم..
لكن حبيبته الأولى كانت..
زائرة الفجر، فلسطين.
كان المعتصم على يقين أن قرار الاعدام من قادة جيش الاحتلال الغادر قد صدر، فهو يدرك خطورة كمائن الرعب التي أوقعهم بها، فجن جنون جنودهم، فهددوا وتوعدوا، لكنه لن يرفع الراية البيضاء مهما كان الثمن، ولن يستسلم مهما حصل. وجاء باحدى رسائله لإحدى مجموعات الأصدقاء:
“الاستسلام مش إلنا". " انا هسه عارف، راح اموت ، راح اموت. لو أكون بدون سلاح بقتلوني. وشايفها زي ما شايفك . قريبة بالنسبة الي".
مع الاحساس بدنو الاجل، ألْهمه الله تعالى الحكمة والصبر والانفة والايثار، فتسامى "المعتصم" على غضبه، وتناسى ظلم الاقربين وأساهُم، وأطلق نداء عفو وصفح ومغفرة، من أحرار ابناء شعبنا عامة، ومخيمنا خاصه، حيث كتب في أحد منشوراته:
"يوم وفاتي أزيلوا ما بصدوركم علي، واعفوا عن زلاتي، وسامحوني، واذكروني بدعوة، فإن الموت لا يطلب رأي أحد، ربما يكون يومي قريباً".
لم يبتعد "علي" عن هذا المنهج، حيث توجه هو الآخر الى الاخوة والاصدقاء والرفاق، سائلاً العفو والمسامحة، عن الزلات والهفوات، والصفح عن سوء الفهم والتقدير. فكتب يقول:
فلتذكروا يا أصدقاء،
فلتذكروا حين تمرّ الذكريات،
بأن ثائراً
عاش غريباً، وغريباً مات،
تذكريه يا فلسطين..
ولتذكروا يا أصدقاء،
بأنه كان يحبّكم،
يحبّكم يحبّكم حتّى البكاء،
ثمّ قضى..
فلتشهد الوردة والطلقة والسيدة العذراء
والدم في الحقول/ والنجم في السماء.
ولم ينس "المعتصم" تذكير رفاقه بغدر الاحتلال وقواته، فكان يهدي وينصح ويلفت الانتباه الى ضرورة الاخذ باسباب اليقظة والحذر، فلا يعني انسحاب القوات الفاشية عدم عودتهم بالحال، وكان دائماً يرسل اشارات يحذرهم فيها، وجاء في احداها:
"يا اخوان، نصيحة مني هذول جيش بتعبوش، ببدلو شفتات عادي، احنا بجوز 50 بنتبع ، همي دوله كامله إمتبعه علينا. عشان هيك يا إخوان ما نركن انهم هيهم فاتو وهيهم طلعو. عادي بجنين برجع كان مرتين وثلاث نفس اليوم".
هذا انت " يا المعتصم" .. نشهد انك في الفجر كنت ترتل ترانيم البعث والانعتاق، وبين فواصل ألم الجروح، رسمت أروع لوحات ملاحم البقاء والخلود، ولحظة توقف الزمن، كبّرت وهللت، وتلوت صلاة مودّع، ودعوت الله ان يربط على قلب أمك، ورجوت شعبك العظيم ان لا يبكيك.
ان خُطى فِعْلك المُشرّف قد صَدَقَتْ نبضات وعدك، وتناسَقَتْ مآثر قولك مع جزيل بَذْلك وجسامة تضحياتك، أشْهرت بلا وجل، أو تردد وخجل، رَفضًك ذلّ الأَنا، وتمردت على عبودية الهوى، واخترت الوطن حباً وطوعاً، فاصطفاك رب العزة شهيدا خالداً مخلّداً، على رؤوس الاشهاد.
سنظل نفتقدك يا "علي"، يا بدر السماء، يا قمر الشهداء، في ليلِ تَواترِ الأزمات بالزمن الصعب، فقد عزّ مثيلك يا راسخ الإيمان، وثابت القلب، وصاحب الموقف الصلب. لذِكْراك (يا عصوم) - على جنبات الارواح - مواقيت لقاء تتجدد، ولكم في القلوب خفقات عزٍ وفخرٍ لا تتوقف، ومن نفحات الايمان المتجذّر نَذْكُرك بخشوع صلاة، وترانيم دعاء، لروحك الرحمة، ولنا من بعد فقدك عناء البحث عن دروب العزة، وسبل الكرامة.
وفي الختام، وقفة إجلال للكاتب "شبح عصوم النور شمسي" الذي يعري العجز والتخاذل، ويكشف سوءات أعداء الشمس ونورها، فالنور بيّن، والظلام بيّن، وبينهما لا بد مشتبهات حارقات.