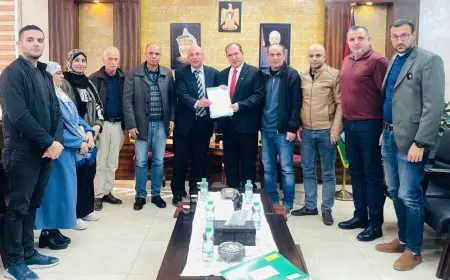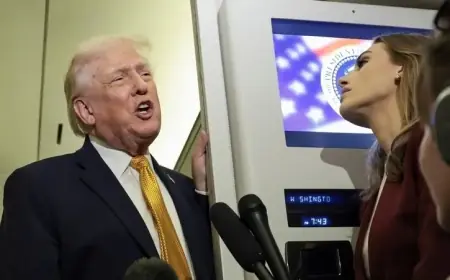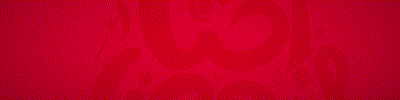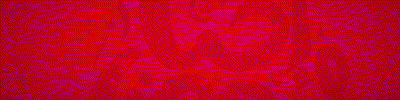حركة فتح، في انطلاقتها
الحلقة الثالثة

حركة فتح، في انطلاقتها
الحلقة الثالثة
***
ويؤكد كثيرٌ من المثقفين والمفكّرين، في الحركة الوطنية الفلسطينية، على أنّ أيّ مجموعة سياسية، تعمل تحت الشرط الاستعماري، وتكون مُحاطة بقوة الاحتلال، وتحت مجْهرِه وضرباته، هي مجموعة غير قادرة على إحداث فرق نوعي. بل يذهب بعض السياسيين للقول؛ إن حركات التحرر في زمن الهزيمة مضطرة إلى الإنزلاق، ولا تستطيع التوقف إلاّ في قاع الهاوية. لهذا نجد أنفسنا مضطرين لمجابهة هذه المقولات، ليس من باب المناكفة، ولكن من باب التحديق في المرآة والمناقشة، وسبر غور هذه اللحظة التاريخية، التي تصطخب فيها غير قوة ورأي ووجهة نظر، وتشهد دعوات حاسمة، تنادي بضرورة أن تستعيد حركة "فتح" دورها، ولتجد لها ولنا الكوابح الكافية، لإيقاف تلك الهرولة وذلك الإنزلاق الذي يومض بتسارعه نحو الحضيض.
ولعلنا، في قسوتنا لتوصيف حال حركة فتح، إنما هي بدافع الحماية والغيرة والحبّ والانتماء، وبهدف إثارة نقاش واجب الوجود وعصف ذهنيّ، بكامل العافية والاستعداد.
عندما وقّعت قيادة فتح على أوسلو 1993،دخلت إلى مجازفة تاريخية، تتطلّب الكثير من العزم والحكمة وحسن الأداء والتماسك الداخلي والحفاظ على الذات؛ هوية وفكرة وبنية، والقدرة على مواجهة الضغوطات، في واقع لم تتعوّد قيادة الحركة العمل داخله، لتحقيق عبورٍ آمن لهذه المجازفة، فإن لم تحقق الأهداف المرجوّة، كان على الحركة أن تضمن الحفاظ على بنيتها وهويتها كحركة تحرر وطني. وأعتقد أن الحركة لم تدقّق تماماً في ماهيّة القيود والاشتراطات التي يمكن أن تكبّلها أو تؤثر على بنيتها وطبيعتها وهويتها، وبدا أن قيادتها كانت مشغولة بمسألة الحُكم أكثر من انشغالها بفكّ طلاسم الاتفاق ومحتوياته الغامضة. وقد لا أجافي الحقيقة إن قلت إن حركة فتح قد هشّمت نظامها الأساسي لحظة توقيع الاتفاق من قبل أعلى مستويات القيادة في المنظمة، ولم تُبقِ لنفسها هامشا لخطة بديلة، أو أي طوق للنجاة، بل قفزت بكلّها وكليلها إلى وحل الاتفاق، وأنجرت بوعي أو دون ذلك إلى التأسيس لفكرٍ جديد، تجاوزت به نفسها وبرنامجها، وناقضت ذاتها، وخذلت مبادئها، وتورّطت في السلطة، ولم تجد المسافة بين السلطة وبينها، حين اعتقد بعض من قيادتها أن السلام استراتيجية بديلة لإستراتيجة الحرب "الثورة"، بينما في الواقع النظري، الفلسفي والفكري والعسكري والسياسي، فإن استراتيجية السلام هي جزء من استراتيجية الحرب وليست بديلا لها، ومن يفصل بينهما يسقط في إدارة الحرب كما في إدارة السلام، وهذا ما كان. وكان أحرى بفتح أن تضع بديلاً إذا انهار السلام - وقد انهار - وأضعفت م.ت.ف.من أجل السلطة، وغابت عن التأثير في م.ت.ف. وهجرت عوامل التواصل مع العروبة والجماهير وعُمْقها الإسلامي والثوري، وخلقت طبقة مستفيدة، وأضعفت الكوادر وفتّتتهم، وأفسدت بعض الذمم، ولم تخلق ثقافة فتحاوية، واستبدلتها بثقافة التسويات. واعتمدت على المساعدات الخارجية واستحقاقاتها، ولم تعتمد على موارد داخلية أو بعيدة عن الشروط. ولم تحقق مكتسبات أو إنجاز لافت، سوى منجزات بسيطة إعلامية أو رمزية. بل وتكاد تشطب هذه الانجازات بتخلّفها عن خطّ المواجهة مع الاحتلال، وهذا ما يفسّر ابتعاد الجماهير، إلى حدّ كبير، عنها.
ثم أنها قدّمت نموذجاً سيّئاً للقيادة واستبداد السلطة واستغلالها، ما خلق رؤوساً ومراكز قوى وتيارات. وعلى مدار أكثر من ثلاثين سنة من السلطة، فقد سيطر الارتباك والتردّد والضبابية في إدارة فتح تنظيمياً وجماهيرياً وسياسياً، لأن فتح -عملياً- وضعت كلّ بيضها في سلّة العملية السلمية التسووية، والتي لم يلمس المواطن منها سوى الموت والاستيطان والإبادة والحواجز والفقر والحصار. كما أن فتح غرقت في التيارات والاستقطابات العربية، ولم تستطع أن تحيّد نفسها تماماً، أو تجد مسافة متساوية بين المتناكفين العرب. لهذا فقد فَقَدت فتح، كثيراً، من الشرعيتين اللتين كانتا تمدّانها بالحيوية والحضور والنفاذ، وهما الشرعية الانتخابية والشرعية الثورية. والآن، فإن من أخطائها القاتلة، أنها قد تستقوي بقوى مختلفة لتثبيت أو انتزاع الشرعيتين أو إحداهما، وهاتان الشرعيتان لا يمكن الحصول عليهما أو إنجازهما إلاّ عبر الجماهير وبها.
وإن اندفاع حركة فتح، وعلى الأصحّ قيادتها المُتنفّذة، ومكابدتها نحو البقاء والسيطرة، يدفعها نحو خيارات خطيرة جداً، تتمثّل في وضع نفسها في خدمة المخططات الإقليمية والدولية، بحيث تتحوّل فتح من حركة ثورية إلى نُخبة سياسية أمنية، تنفّذ برنامجاً يصبّ في خدمة الرؤية الكبرى للقوى المتحكّمة ومصالحها المختلفة، لترتيب المنطقة واستلاب ثرواتها، ورسم سياسات بعيدة المدى. وعملت على نشر المقولات والدعوات الاجتماعية والفكرية والسياسية الجديدة، التي تفارق روح فتح وحمولتها ونظامها الأساسي، والذي سعى البعض، إلى تحويله من نظام سياسي جامع وأصيل، إلى نظام داخلي منزوع الأهداف والمبادئ والأساليب، التي تربّت عليها الأجيال. وإذا أضفنا إلى ذلك كله هيكليات فتح التي عفا عليها الزمن، وتجاوزتها الأحداث، ولم تعد تستطيع إلا الحفاظ على مصالحها الصغيرة، وكذلك بروز التيارات المختلفة والمرتبطة بأجندات متعارضة، صغيرة وكبيرة، ومكشوفة وغير مرئية، فإنّ ذلك يؤدي، مع المال السياسي، إلى أن تصطدم فتح ومشروعها، إذا بقي منه شيء، في حائط من الفولاذ.
وكل ذلك على خلفية عدم الإنجاز السياسي والإخفاق الإداري،والتخشّب الفكري أو غياب الرؤية،وانعدام الكريزما الشخصية..فإن كل ما نشهده من تراجع للصورة الفلسطينية والنموذج الفلسطيني، ورغبة البعض في أن يغسل يديه من قضيتنا، هو نتيجة لما وصلت إليه رائدة الكفاح والمقاومة فتح، التي استمدت شرعيتها وتأثيرها الغلاّب من مشروعها الكفاحي، الذي استعجلت وتعجّلت التاريخ، من أجل اتفاق غامض رسم مستقبلاً غامضاً، ندفع كلُّنا ثمن ضعفنا فيه، وهزيمتنا المدويّة.
وتدرك فتح أنها أمام حقائق صادمة، أوّلها؛ أن حلّ الدولتين قد ذهب مع الاستيطان، وأن حلّ الدولة الواحدة سيقود إلى نظام أبرتهايد مخيف، نرى إرهاصات حرائقه في كل أرضنا المحتلة، وأننا ذاهبون إلى حصار، سيفرضه المستوطنون وينكّلون بنا وبأشجارنا وبيوتنا ودروبنا، فما هو السيناريو الذي وضعته فتح لمواجهة هذا الرعب القادم؟ والحقيقة الثانية؛ أن الفصائل الفلسطينية قد انفرط بعضها أو انكمش أو فَقَدَ تأثيره المعهود، أو يسعى إلى خيارات، إنْ تمّت، ستقضي على مشروعنا الوطني! فماذا أعدّت فتح لإنهاض الفصائل والحيلولة دون التشظّي وتخريب الوحدة الوطنية، عبر انتخابات واجبة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسي. والحقيقة الثالثة؛ أن القوى الكبرى لن تهبّ لتقديم "الدولة" لنا على طبق نظيف، لأسباب معلومة، وأن عمقنا العربي يشهد درساً في الخراب والطحْن والعدمية، وأنه منشغل بنزيفه المهول أو بتطبيعه المجّانيّ الخائف مع الاحتلال. عدا عن حقائق "داخلية" تشير إلى أزمات اقتصادية واجتماعية ووطنية وسياسية شديدة الصعوبة والتعقيد، من وضع قطاع غزة الرجراج، والخوف من التهجير، وانعدام فرصة حلّ الدولتين، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة والتسطّح الفكري..إلى تعدد الخطابات. فأين فتح من كل هذا؟ وهل تمتلك إجابات شاملة وعلمية وواقعية؟