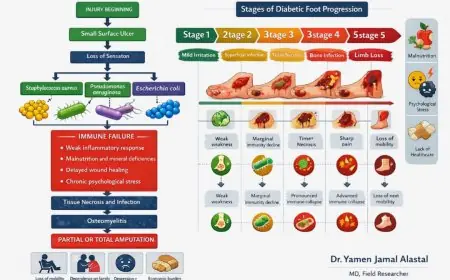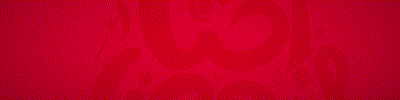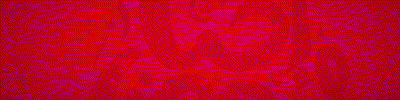إسرائيل من الحروب الوجودية إلى التوسعية

نبهان خريشة
لم يعد من الممكن النظر إلى الهجمات الإسرائيلية الحالية على إيران على أنها ضربات دفاعية تهدف إلى تحييد خطر نووي محتمل. فطبيعة الهجمات، وتوقيتها، وتداعياتها الإقليمية تشير إلى تحول استراتيجي أعمق، وهو الانتقال من الدفاع عن "الوجود" إلى مشروع "الهيمنة". فإسرائيل لم تعد تكتفي بردع أعدائها، بل تسعى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية. إن الهجمات الإسرائيلية على إيران لم تستهدف منشآت نووية فحسب، بل ضرب بنية تحتية عسكرية ومدنية على امتداد الجغرافيا الإيرانية، مما يثير تساؤلات حول النية الحقيقية خلف هذه الهجمات. هي ليست حربًا استباقية فحسب، بل رسالة واضحة بأن إسرائيل مستعدة لاستخدام تفوقها العسكري المطلق لفرض معادلات جديدة في الإقليم.
منذ تأسيسها عام 1948، قدّمت إسرائيل نفسها للعالم كدولة تواجه تهديداً وجودياً دائماً، محاطة بدول عربية ترفض الاعتراف بها وتسعى إلى تدميرها. هذه السردية كانت أساس العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وركيزة دعم الغرب السياسي والعسكري لها لعقود. لكن، في العقدين الأخيرين، وخصوصاً خلال عهد بنيامين نتنياهو، شهدنا تحوّلاً تدريجياً من الحروب التي تُخاض تحت ذريعة "الدفاع عن الوجود" إلى حروبٍ ذات طابع توسعي واضح، تسعى لتكريس الهيمنة وفرض وقائع جيوسياسية وديمغرافية على الأرض.
وشهدت العقيدة الأمنية الإسرائيلية في العقود الأولى قيامها على فكرة "الدفاع المبكر" و"الردع"، كما تجلّى ذلك في حروب 1948 و1967 و1973، حيث كانت إسرائيل تصور تلك الحروب كصراع للبقاء، رغم أن بعضها – كحرب 1967 – حمل طابعًا هجوميًا مبكرًا، لكنه ظل يُسوّق في الإطار الوجودي. إلا أن هذا التصور تغيّر جذرياً منذ بداية القرن الحادي والعشرين، بالتوازي مع صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى سدة الحكم، بزعامة نتنياهو، الذي عمل على إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي، وفقا لفلسفة جابوتنسكي "الجدار الحديدي" لإخضاع العرب، بحيث لم يعد مقتصراً على الدفاع عن الدولة "الديمقراطية" الوحيدة في الشرق الأوسط، بل أصبح يشمل "توسيع حدودها"، و"منع قيام كيان فلسطيني"، و"السيطرة الدائمة على الضفة الغربية".
إن الحرب على قطاع غزة مثلًا، تتجاوز مساحة القطاع الصغيرة لتكون رسالة ردع ولمنع تشكل أي كيان فلسطيني مستقل وقادر. كذلك، تأتي الضربات المتكررة على سوريا ولبنان ضمن إطار هندسة المشهد الأمني في المشرق العربي لصالح إسرائيل، بما يتضمن تقويض أي وجود عسكري أو سياسي يمكن أن يهدد تفوقها. وفي ذات السياق، ويُنظر إلى أن أي ضربة عسكرية ضد إيران، أو ضد ميليشيات محسوبة عليها، كأداة لإعادة رسم ميزان القوى في المنطقة، وإبقاء الدول العربية في حالة استنزاف دائم، تمنعها من تشكيل تكتل أو مشروع نهضوي مضاد.
وفي عهد نتنياهو، تم تحويل الأمن من مسألة حماية الحدود إلى مشروع سيطرة شاملة. ويمكن رصد ذلك في ثلاثة مسارات متوازية: الاستيطان حيث تضاعفت أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، وصار ضم أجزاء منها واقعًا شبه رسمي، بدعم مباشر من حكومة نتنياهو. وترافق ذلك مع سنّ قوانين تُكرّس "يهودية الدولة" وتُقصي الفلسطينيين. والمسار الثاني يتمثل الوقائية المتكررة، حيث لم تعد إسرائيل تنتظر تهديداً فعليًا لشنّ حرب، بل باتت تُبادر إلى الضربات العسكرية تحت مبرر "منع التهديد" كما في كما في حريها الحالية على غزة أو ضرباتها في سوريا ولبنان. وهذا يعكس عقيدة هجومية توسعية وليست دفاعية وتفكيك. أما المسار الثالث فهو إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، فبدلاً من البحث عن تسوية سياسية، انتهج نتنياهو سياسة تقويض كل أدوات النضال الفلسطيني، سواء عبر حصار غزة والحرب عليها، أو تعزيز الانقسام الفلسطيني.
وفي ظل هذا التحول، بات الحديث عن "التهديد الوجودي" مجرد شعار دعائي يستخدم عند الحاجة لتبرير العنف المفرط أو استجلاب الدعم الدولي. أما على الأرض، فالحقيقة أن إسرائيل – لا سيما في عهد نتنياهو – لم تعد تخشى على وجودها، بل تسعى لتعزيز نفوذها وضمّ ما تبقّى من فلسطين التاريخية، وفرض رؤيتها لما تسميه "الأمن القومي الإسرائيلي"، والتي تتضمن بقاء الفلسطينيين تحت السيطرة أو التهجير التدريجي.
إن الحلم التوراتي "إسرائيل من النيل إلى الفرات" ليس بالضرورة أن يتحقق بالمفهوم العسكري الحرفي للكلمة، من خلال الاحتلال المباشر للمناطق الواقعة بين النيل والفرات، بل قد يتحقق بأدوات أكثر نعومة وخطورة، تجمع بين القوة الخشنة والهيمنة الناعمة. فما يجري في المنطقة اليوم هو تحوّل نوعي في شكل "التوسع"، بحيث أن إسرائيل ليست بحاجة لنشر قواعد عسكرية على ضفاف النيل أو شط العرب، بل تسعى إلى تكريس نفوذ يجعلها اللاعب الرئيسي في رسم مستقبل المنطقة، وحين سيطرتها تصبح طرفًا لا يمكن تجاوزه في كافة المجالات، من الطاقة إلى الأمن، ومن الاقتصاد إلى التحالفات الإقليمية.
لكن ربما يكون الوجه الأخطر لهذا المشروع التوسعي، هو ما يحصل في العلن تحت عنوان "السلام" و"التطبيع". فبعد "اتفاقيات أبراهام"، لم يعد الأمر يقتصر على علاقات دبلوماسية، بل شهدنا انفتاحًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا غير مسبوق بين إسرائيل وعدة دول عربية. شراكات في الزراعة والمياه والطاقة والتقنية، وأسواق عربية تفتح أبوابها أمام الشركات الإسرائيلية، ومشاريع إقليمية تجعل من إسرائيل مركزًا اقتصاديًا حيويًا. وهكذا، تصبح الأسواق العربية امتدادًا للنفوذ الإسرائيلي، وتتحول الثروات الطبيعية – كالنفط والغاز والمياه – إلى أوراق تفاوض بيد تل أبيب. وليس مستبعدًا أن تنشأ بنى تحتية إقليمية (مثل خطوط نقل الغاز أو الطاقة) تكون إسرائيل مركزها، بما يحولها إلى عصب اقتصادي في المنطقة.
وفي هذا السياق، لا يعود احتلال الأرض ضرورة، بل تكفي السيطرة على الموارد والأسواق والقرارات السيادية، حتى تُفرض الهيمنة بحكم الواقع، وتُحقق الأحلام التوراتية دون إطلاق رصاصة. ولا يخفى أن أحد أبرز أدوات هذا المشروع هو تغذية الانقسام داخل الدول العربية نفسها، سواء عبر دعم مشاريع التفتيت الطائفي والعرقي، أو عبر الاستثمار في الأزمات والصراعات الداخلية. فكلما ضعفت الدولة الوطنية، وانهارت المؤسسات، باتت أكثر قابلية للخضوع للنفوذ الخارجي، وأقل قدرة على مواجهة الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية.
الخلاصة إن إسرائيل اليوم، في عهد نتنياهو، لم تعد تخوض "حروبًا وجودية"، بل تدير مشروعًا توسعيًا يتوسل القوة والردع، ويتهرّب من أي تسوية عادلة. وهذا التحول لا يعبّر عن ثقة بالنفس، بل عن أزمة أخلاقية واستراتيجية ستدفع ثمنها لاحقًا، عندما تكتشف أن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر الجدران والمستوطنات، بل عبر الاعتراف بحقوق الآخرين في العيش بحرية وكرامة. وهذا التحول من "الدفاع إلى التوسع" يحمل في طياته بذور التهديد الحقيقي، بخلق بيئة قابلة للانفجارات المستمرة