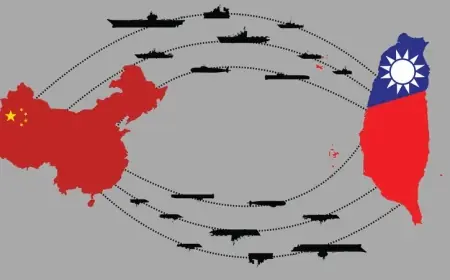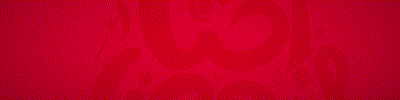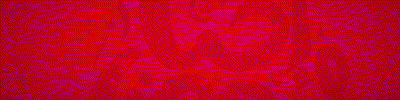الدكتور وليد سيف كما شاهدناه: حكواتي التغريبة وراوي الوجع الفلسطيني

من مذكّرات المستشار د. أحمد يوسف
لم يكن الدكتور وليد سيف مجرد اسمٍ في شريط الذكريات، بل ظلّ في وجداني رمزًا لتلك النخبة الفلسطينية المثقفة التي جمعت بين رصانة الفكر، وصدق الالتزام، وحرارة الانتماء. رجلٌ لا يزال عطاؤه متجدّدًا، يتدفّق من قلمه حبرٌ يُحيي الذاكرة، ويعيد تشكيل وعينا بالجمال والتاريخ والوطن.
ولد الدكتور وليد سيف في مدينة طولكرم عام 1948، وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في فلسطين، ثم واصل دراسته الجامعية في الجامعة الأردنية؛ وكان من بين الطلاب الناشطين في الحراك الوطني. وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس في اللغة والأدب العربي، انتقل إلى المملكة المتحدة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة لندن (SOAS)، متخصّصًا في المسرح والشعر الأندلسي. وقد جمع في مسيرته بين العمل الأكاديمي والإبداعي، فاشتغل أستاذًا جامعيًا وباحثًا، قبل أن يتفرغ للكتابة الدرامية التي رسّخت اسمه كأحد أبرز كتّاب السيناريو في العالم العربي.
عرفته لأول مرة عام 1994، في واحدةٍ من محطات الغربة، بمدينة "فالز تشيرش" (Falls Church) على أطراف العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث كان يعمل باحثًا بجامعة جورج واشنطن. كنّا نقطن في ذات العمارة بحي الأبراج العالية (SkyLines)، وكانت لقاءاتنا عابرة، إذ لم أكن قد قرأت له أو شاهدت من أعماله شيئًا آنذاك، ولم أكن على دراية كافية بمكانته. غير أنني انتبهت إليه منذ اللقاءات الأولى؛ فقد لفتني بحديثه اللبق، وصوته الهادئ، وطريقته التي تجمع بين أناقة العبارة وعمق المعنى.
كان واضحًا أنني أمام شخصية تنتمي إلى عالم الأدب والفكر؛ فلا تخطئه العين ولا القلب. كان الدكتور وليد سيف له حضور مميز، وشَعره الكثيف، وملامحه الوقورة، تكاد تقول إن هذا الرجل خرج من بين دفاتر الشعراء، أو من مشهدٍ روائي.
كنّا نلتقي أحيانًا – إن لم تخني الذاكرة – في المركز الإسلامي بـ"دار الهجرة"، القريب من مكان إقامتنا. فقد كانت المسافة قصيرة، كما يقولون "مقرط عصا"، ودار الهجرة كانت آنذاك ملتقى لكثير من أبناء الجالية، ومتنفّسًا روحيًا وثقافيًا واجتماعيًا لنا جميعًا في ديار الغربة وعالم "الآخر".
لم تطل إقامته هناك، إذ كانت – كما فهمت لاحقًا – جزءًا من مهمة أكاديمية أو زيارة ثقافية قصيرة، فافترقنا بعد أشهرٍ قليلة. لكن بقيت تلك الصورة الأولى عالقة في ذهني: رجلٌ وقور، مثقف، يتمتع بسمتٍ من الهدوء والاتزان، إسلاميٌّ بتوجّهٍ عروبي أصيل، ومن عائلةٍ لها سهمٌ في التاريخ النضالي الفلسطيني.
وغابت الوجوه في زحمة الاغتراب والسفر، ومضت معها الكثير من السنوات، حتى جاء ذلك العمل الدرامي الكبير الذي أعاد اسمه إلى الواجهة بقوة: التغريبة الفلسطينية، والذي بدأ عرضه في أكتوبر عام 2004. كان هذا المسلسل علامة فارقة في الدراما العربية، حيث تناول – برؤية درامية فذّة – مأساة الشعب الفلسطيني منذ أواخر الثلاثينيات وحتى نكبة عام 1948، وما تلاها من سنوات التشريد والمعاناة في الخمسينيات والستينيات.
عندها أدركت أن اليد التي كتبت هذا النص ليست مجرد كاتب درامي، بل مؤرخٌ إنسانيٌ للنكبة، وصوتٌ ناطقٌ بألم التشريد الفلسطيني، بلغةٍ أقرب إلى الشعر منها إلى الحوار، وبروحٍ تلامس جوهر القضية لا سطحها.
ومع مسلسل ربيع قرطبة، التي سبق لي زيارتها ومشاهدة عظمة التاريخ الإسلامي في ربوع الأندلس، زاد إعجابي بالرجل وإبداعاته التاريخية. ثم جاءت أعماله مثل ملوك الطوائف، وصلاح الدين الأيوبي، فرأيت كيف تسلّل الدكتور وليد سيف إلى قلب الدراما العربية، لا بوصفه صانعًا للحبكات فقط، بل بكونه مُعيدًا لصياغة الوعي بالتاريخ والهوية، ومدافعًا عن روح الأمة في وجه الرداءة والتشويه.
بدأت أتابع أعماله، وأطالع مقابلاته الفكرية وإطلالاته المتلفزة، وأكتشف في كل مرة وجهًا جديدًا لهذا الرجل؛ فهو لم يكن فقط كاتبًا دراميًا، بل أديبًا ومفكرًا يحمل مشروعًا حضاريًا متماسكًا، ينهل من التراث بروحٍ نقدية بنّاءة، ويقدّم الإسلام في صورته الجمالية والإنسانية. ولا شك أن آخر رواياته خريف إشبيلية سوف تجد طريقها إلى المسلسلات الرمضانية القادمة.
إن ما يميّز الدكتور وليد سيف بحق، أنه ظلّ وفيًّا لفلسطين والأندلس؛ ليس بوصف الأولى قضيةً سياسية مركزية في الوجدان الإسلامي فحسب، بل كهويةٍ حضارية وروحية تتجلّى في لغته. أما الأندلس، كمحطة حضارية وتاريخية إسلامية، فلها هي الأخرى مكانتها في اختياراته لموضوعات أعماله. لقد ظلّ يؤمن بأن فلسطين والأندلس لا يجوز أن تكونا مجرد خلفيتين باهتتين لأي سرد، بل تبقيان في القلب، حاضرتين ومشتعلتين.
تلك اللقاءات العابرة في حي (SkyLines) كانت بدايةَ معرفة، لكنها تحوّلت مع السنين إلى متابعة وجدانية وفكرية لمسيرة قامةٍ أدبيةٍ نادرة. واليوم، وبعد مضيّ عقود، ما زلت أجد في كل ما يكتبه أو يُعرض له، ما يثير العقل، ويحرك القلب.
الدكتور وليد سيف ما زال بيننا، حيًا بحضوره، وبصيرته، ومشروعه الثقافي الممتد. وكل ما نتمناه هو أن تبقى أعماله تُدرّس، وتُحلّل، وتُكرَّم بما يليق بمكانته، وبما قدّمه من إضافة نوعية للثقافة والدراما والوعي العربي.
ومع نكبتنا الثانية الكبرى، قطعت عهدًا على نفسي أن أبذل الجهد لاستكمال الجزء الأول من التغريبة، دون انتظار سنوات طوال لتسجيلها، فبدأت بالتوثيق مبكرًا. ولكن فجعتنا الكارثة، وأحالتنا – نحن ومن معنا من طاقم العمل – إلى نازحين. وإذا كتب الله لنا عمرًا نعيش فيه ونُشرف على تغريبتنا الثانية، فسيبقى الدكتور وليد سيف هو أستاذنا ومرشدنا الأول في مشهدية هذا الجزء القادم، بكل ما احتضنته وقائعُه من صور القتل والتجويع والحصار.