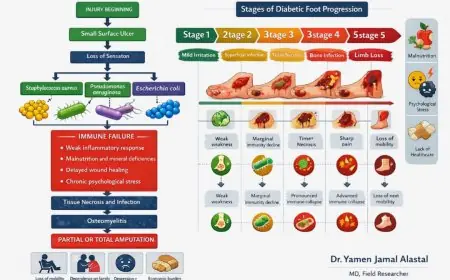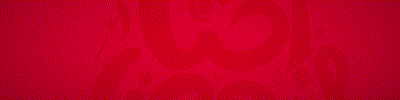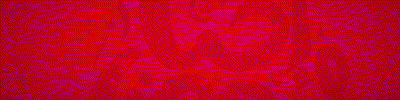أين المرونة في الاقتصاد الأردني حالياً؟

في كل مرة حذرت فيها من احتمالات حدوث تراجع في الاقتصاد الأردني كان توقعي صائباً. فقد عارضت المرحوم د. خليل السالم محافظ البنك المركزي الأردني عام 1972 عندما قرر تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، والذي جاء لأول مرة بتضخم من رقمين (12%). وهو حدث لم يسبق للأردن أن مرَّ به أو عاناه قبل ذلك. وفي عام 1988 حذرت في مذكرة مكتومة من انخفاض سعر صرف الدينار. وقد وبِّخت عليها، ولكن في مطلع 1989 حصل الذي حذرت منه وكنت أرجو ألا يحصل، ولكنه حصل وأدى إلى ما سمي حينها "هبة معان" خاصة بعدما انتهت الحرب العراقية الإيرانية، وتقلصت التعاملات بين البلدين وخسر كثير من الأردنيين مصادر عيشهم.
الملك عبدالله الثاني واستقرار سعر صرف الدينار
ومنذ ذلك الوقت، والسياسة الاقتصادية في الأردن مسكونة بهواجس الخوف على قيمة الدينار وسعره. وقد نجح الأردن منذ بداية التسعينيات وحتى الآن في الحفاظ على سعر صرف الدينار ثابتاً عن طريق ربطه بالدولار. وبقيت معدلات الارتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مستقرة. وخلال السنوات الأولى من تسلم الملك عبد الله الثاني لمقاليد الحكم، شهد الأردن معدلات نمو عالية (حوالي 6% سنوياً)، ومعدلات تضخم متدنية (2-3%)، واستقراراً كبيراً في سعر صرف الدينار، وزيادة مطردة في الصادرات، والحفاظ على مخزون كافٍ من الاحتياطات الأجنبية لدى القطاع المصرفي الرسمي منه والخاص.
وأذكر أن ميلتون فريدمان، الاقتصادي الأميركي المحافظ (نيو كلاسيكي) كان يؤمن أن الذي يؤثر على الاقتصاد أكثر من سعر الفائدة هو عرض النقد. وعندما سُئل "ولكن زيادة عرض النقد تؤدي إلى هبوط سعر الفائدة لتوفر السيولة (العرض) قياساً إلى الطلب؟". فقال: هذا صحيح في المدى القصير، ولكن زيادة عرض النقد تكون مصحوبة عادة بزيادة الأسعار، والتي لا بد أن تؤدي في الدورة الاقتصادية المتوسطة إلى زيادة أسعار الفائدة. أما في المدى الطويل، فتبقى العلاقة طردية بين عرض النقد وأسعار الفائدة بسبب ما سماه "أثر غيبسون" أو ( Gibson Effect) حيث يدخل المضاربون السوق بأفكار شتى متباينة تجعل الأمور واضحة الاتجاه، ولكن حجم العلاقة وطبيعتها تبقى مجهولة وصعبة القياس لأنها تعتمد على رؤى الناس وأحكامهم الشخصية، بما في ذلك مديرو البنوك والمؤسسات المالية.
الدولار وانهيار سوق العقارات الثانوية
وما دام أن الولايات المتحدة، مصدِّرة الدولار والوحيدة المتحكمة في الكميات المعروضة منه، بقيت قوية وحاكمة وحيدة في العالم، فإن هذا يعني أن قدرة الولايات المتحدة على صون سعر صرف الدولار تبقى ثابتة ومؤثرة. ولكن المشكلة تقع حين تتغير هذه الفرضية الأساسية. وهذا ما حصل عام 2008، حين انهار سوق العقارات الثانوية ( Secondary Market Mortgage"، وانتقل ذلك إلى باقي الأوراق المالية كالسندات والأذونات والقبولات وسوق ( Junk bonds) أو السندات الضعيفة التي لا يريدها أحد، والتي تحولت على أيدي بعض المؤسسات في ( وول ستريت) إلى مصدر ثروة هائل. ولقد أدى انهيار السوق المالي في شارع المال إلى تراجع مثله في سوق السلع والبضائع.
وقامت الولايات المتحدة في إدارة الرئيس باراك أوباما الجديدة بإصدار فوري لنحو (800) مليار دولار لدعم المؤسسات المالية المسؤولة عن الأزمة باستثناء مؤسسة "ليمان براذرز". وقد استمر ضخ النقود حتى بداية حكم الرئيس، جو بايدن الذي ضخ أكثر من (1.5) تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، والذي ما يزال يضخ عبر الموازنة العامة وعجوزاتها وتقصيرها عن سداد التزاماتها بمليارات الدولارات باستمرار، أو ما يسمى ( Deficit Financing).
ليست اللاعب الوحيد في العالم
إذن، اضطرت الولايات المتحدة أن تعترف أنها لم تعد اللاعب الوحيد في العالم. وقد قيل يوماً إنه إذا عطست الولايات المتحدة، فإن العالم كله سيصاب بالزكام. ولكن هذا القول يصدق على الأسواق المالية الصينية بحد أقل، وعلى اليورو بوند وعلى كثير من الاستثمارات المالية المتاحة في العالم. والسؤال هو: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن ترفع الفوائد لتحافظ على قيمة الدولار؟
هذا يجب أن يقض مضاجع كل من يعتقد أن استقرار عملته مرتبط باستقرار الدولار. إن رفع نسبة الفائدة بربع نقطة مئوية سيزيد كلفة الدين العام الأميركي البالغ 35 تريليون دولار بقيمة تقارب 87.5 مليار دولار في السنة، وفي هذا إضافة لأعباء جديدة على الخزانة.
وما دام معظم الدولارات والأوراق المالية الصادرة بالدولار ما تزال خارج الولايات المتحدة، والإقبال عليها كبيراً يبقى الدولار ثابتاً. ولكن الولايات المتحدة تواجه إجراءات من دول عديدة باللادولرة ( Dedollarization)، فماذا سيكون مصير الاقتصاد الأميركي لو بدأت هذه الدولارات بالعودة إلى الولايات المتحدة؟ وهذا محتمل، وقد تكون نتائج الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا في غير مصلحة الولايات المتحدة ما سيقوي خصومها على سلبها واحداً من أهم عناصر قوتها، وهو الدولار ومقبوليته في العالم.
قانون قيصر يحرم الأردن مبالغ اكبر من الدعم الأميركي
تقدم الولايات المتحدة للأردن مساعدات تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار سنوياً، يذهب أكثر من نصفها إلى دعم الموازنة، وبمعنى آخر يصل دعم الموازنة الأردنية من الولايات المتحدة إلى 845 مليون دولار. ولكن انصياع الأردن لقانون "سيزر"، أو قانون "قيصر لحماية المدنيين في سورية" للعام 2019 ، يحرمه من مبالغ أكبر من ذلك. ولو حسبنا كلف ذلك القانون لوجدنا أنه يضيع على الأردن على الأقل 500 مليون دولار كهرباء مباعة إلى لبنان عبر سورية. وحوالي 500 مليون دولار عائدات مرور ترانزيت عبر سورية من وإلى دول الخليج وإلى أوروبا. ويكبد الأردن نحو ملياري دولار نتيجة للجهود العسكرية والأمنية المبذولة لحماية الأردن وحدوده من مهربي المخدرات والأسلحة، والذين يرتبطون بعصابات دولية منظمة. فإذا كان المبلغ المقدم للموازنة لا يعادل ثلث تقديرات الخسائر الناجمة عن إصرار أميركا تطبيق قانون سيزر، والذي بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي لخلق علاقة وثيقة مع سورية نأمل نحن في الأردن أن تنجح.
وهناك بالطبع سياسات أميركا المعادية لفلسطين ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني علينا في الأردن أن نقول لشركائنا الاستراتيجيين إن استفادتهم من الموقع الجيوسياسي الأردني، ومنع الأردن استخدامَ أراضيه ضد الجيران تستحق أن تمنح على الأقل (5) مليارات دولار سنوياً.
أولوية الإصلاحات الإدارية
أما النقطة الأخيرة، والتي تستحق النظر فهي أن الاقتصاد الأردني لا يستطيع أن يستمر على المنهج المعلب نفسه الذي يغفل الحقائق الأساسية في أن العالم يتغير من حولنا، وأن الفرضيات المقبولة بأن صندوق النقد الدولي هو الأسلم لنا منهجية تبقى صحيحة إلى الأبد. نجاح الأردن أساساً في مواجهة كل الصعوبات والتحديات هو المرونة ( Resilience) الذي تمتعت به القيادة الأردنية العليا وانتقلت عدواها منهم إلى باقي القيادات والقطاعات في الدولة. ولكن إذا جمدنا أنفسنا فإن البطالة سترتفع، والتضخم سيزداد، والاستثمار لن يأتي بالمقادير التي نحتاج إليها أو نتخيل أنها قادمة بعد اليوم التالي من نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة وفلسطين، وأن البطالة ستتفاقم.
إن العقدة في المنشار هي ضعف الإدارة العامة وتراجعها، وإن الحكومة قد أصبحت عبئاً ثقيلاً على الشعب الأردني. ولذلك، لو خُيرت بين واحدة من الإصلاحات الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية لاخترت الثالثة، واعطيتها الأولية. فلا اقتصاد ولا سياسة إذا بقيت الإدارة العامة مكلفة (سبب معظم الديون) وغير كفؤة، ومحدودة التنافسية.
النموذج الاقتصادي المعتمد بالتركيز على توفير مزيد من المال بالضرائب والديون والرسوم لتمويل نفقات حكومية على توظيفٍ مبالغٍ فيه ومتدني الكفاءة والإنتاجية سيقود اقتصادنا إلى حلقة مفرغة بوجود ضغوط خارجية أو بعدم وجودها. ومنذ متى كان الأردن بدون تحديات خارجية؟
الحل موجود، ولكن من يعلق الجرس؟
علينا في الأردن أن نقول لشركائنا الاستراتيجيين إن استفادتهم من الموقع الجيوسياسي الأردني، ومنع الأردن استخدامَ أراضيه ضد الجيران تستحق أن تمنح على الأقل (5) مليارات دولار سنوياً.