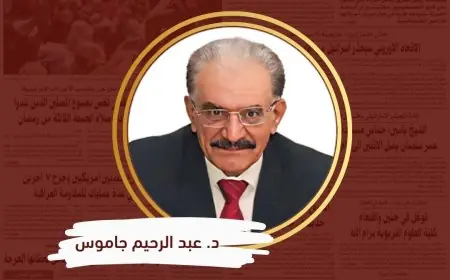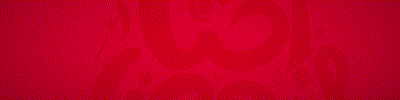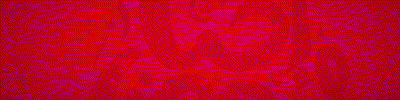2026 على حافة العتمة المعرفية: كيف نحاصر أبناءنا بالجهل الرقمي ونحن نواجه العالم بلا تعليم للذكاء الاصطناعي؟
صدقي أبو ضهير

صدقي أبو ضهير
باحث ومستشار بالإعلام الرقمي
ندخل عام 2026 مثقلين بالسياسة، محاصرين بالاقتصاد، ومُنهكين تنموياً، لكن الأخطر من كل ذلك أننا ندخله بلا وعي معرفي بحجم التحوّل الذي يعيد تشكيل العالم أمام أعيننا. الذكاء الاصطناعي لا ينتظر الاستقرار السياسي، ولا يفاوض على الميزانيات، ولا يعترف بالأزمات. هو يتقدّم بصمت بارد، بينما نحن نُقنع أنفسنا أن الأولويات الوطنية لا تسمح الآن، وأن الظروف أصعب من أن نفتح ملفاً جديداً اسمه تعليم الذكاء الاصطناعي. هذا التبرير، مهما بدا واقعياً، يحمل في داخله بذرة خطر استراتيجي طويل الأمد.
في البيئات المستقرة، يُدرّس الذكاء الاصطناعي كأداة قوة. أمّا في البيئات المأزومة، فهو مسألة بقاء. المجتمعات التي تعاني سياسياً واقتصادياً تحتاج المعرفة أكثر لا أقل، لأنها بلا نفط، وبلا أسواق مفتوحة، وبلا سيادة رقمية كاملة. المعرفة هنا ليست رفاهية، بل رأس المال الوحيد الذي لا يُصادَر ولا يُحاصَر. حين نؤجل إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم بحجة الواقع الصعب، فنحن عملياً نُسلّم بأن أبناءنا سيواجهون عالماً أعقد بأدواتٍ أضعف.
الذكاء الاصطناعي لا يعني مختبرات متقدمة ولا أجهزة باهظة فقط، بل يعني عقلية جديدة في التفكير، في التحليل، في طرح السؤال قبل قبول الإجابة. حين يغيب هذا عن المناهج، يتعلّم الطالب أن التكنولوجيا شيء يُستهلك لا يُفهم، وأن الخوارزميات قوى غامضة لا أنظمة قابلة للنقد والمساءلة. في واقع سياسي هش، هذا النوع من الجهل خطير، لأنه يُنتج وعياً سهل التوجيه، سريع التصديق، ضعيف المقاومة الرقمية، وغير قادر على تمييز الحقيقة من التزييف.
اقتصادياً، ندخل 2026 فيما فرص العمل التقليدية تتقلّص، والوظائف الرقمية تتوسّع، والعمل الحر والعابر للحدود يصبح الملاذ الوحيد لكثير من الشباب. من دون تعليم الذكاء الاصطناعي، لا كمهارة تقنية فقط بل كثقافة عمل، سنُخرّج أجيالاً تنافس محلياً في سوق عالمي، وتُسأل عن مهارات لم تتعلّمها، وتُقاس بأدوات لم تُدرّب عليها. هذا ليس فشل أفراد، بل فشل منظومة دفعت أبناءها إلى سباق دون أن تعطيهم حذاء الجري.
تنموياً، الحديث عن الذكاء الاصطناعي في التعليم ليس ترفاً نظرياً، بل استثمار منخفض التكلفة وعالي الأثر مقارنة بقطاعات أخرى. يمكن إدماجه تدريجياً، بمحتوى أخلاقي، وبمشاريع تفكير، وبربط مباشر مع الواقع المحلي. لكن حين نغلق هذا الباب، نُراكم فجوة معرفية تتحول لاحقاً إلى فجوة اجتماعية، ثم إلى فجوة سياسية، لأن من لا يفهم أدوات العصر لا يملك لغة العصر، ومن لا يملك اللغة يُستبعد من التأثير.
وسط كل هذا، يُترك الأهل وحدهم في المواجهة. الأسرة تصبح المدرسة البديلة، والقلق يصبح المنهج الخفي. هل يستخدم ابني الذكاء الاصطناعي ليتعلّم أم ليتهرّب؟ هل ما يراه حقيقة أم محاكاة؟ هل أفهم أنا أصلاً ما يواجهه؟ الضغط يتضاعف، والثقة تتآكل، لأن المؤسسة التعليمية غابت عن أخطر ساحة تشكّل وعي الجيل.
القول إن الظروف لا تسمح هو في ظاهره عقلاني، لكنه في عمقه استسلام. التاريخ يُظهر أن الأمم التي سبقت في التعليم فعلت ذلك غالباً في أصعب مراحلها، لا في أوقات الرفاه. إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم ليس إنكاراً للواقع السياسي والاقتصادي، بل ردّ ذكيّ عليه. هو إعلان بأننا نراهن على الإنسان حين تعجز الموارد، وعلى العقل حين تُغلَق الجغرافيا.
عام 2026 لن يكون رحيماً بالمتأخرين معرفياً. الذكاء الاصطناعي سيُدرَّس أو سيُستخدم ضد من لم يفهمه. وبين الخيارين، الفارق ليس تقنية، بل قرار. قرار أن نعلّم أبناءنا كيف يفكّرون في عالم تحكمه الخوارزميات، لا أن نتركهم يتعلّمون متأخرين، خائفين، وتحت ضغط واقع لم نُعِدّهم له. هنا، يصبح غياب مادة دراسية مسألة مصير، لا جدول حصص.
———
المجتمعات التي تعاني سياسياً واقتصادياً تحتاج المعرفة أكثر لا أقل، لأنها بلا نفط، وبلا أسواق مفتوحة، وبلا سيادة رقمية كاملة. وحين نؤجل إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم بحجة الواقع الصعب، فنحن عملياً نُسلّم بأن أبناءنا سيواجهون عالماً أعقد بأدواتٍ أضعف.