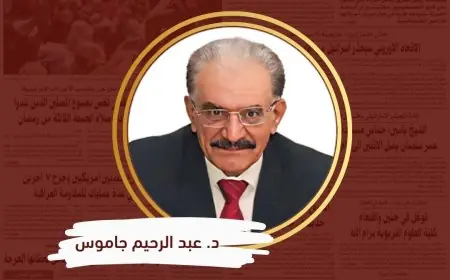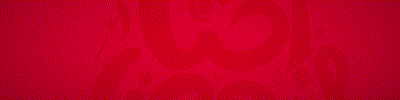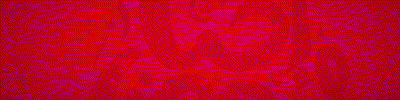العودة إلى الشعب: مأزق التعددية الحزبية وفشل التمثيل السياسي
د. إبراهيم نعيرات

د. إبراهيم نعيرات
في اللحظة الفلسطينية الراهنة، لم تعد الأزمة السياسية مجرد نتيجة مباشرة للاحتلال أو لتوازنات إقليمية ودولية معقدة، بل بات واضحًا أنها أزمة بنيوية داخل النظام السياسي الفلسطيني نفسه، تتعلق بعلاقته بالشعب، وبطبيعة الفعل الحزبي، وبغياب آليات المساءلة والمشاركة. فالشعب الفلسطيني، رغم كل ما تعرض له من نكبات تاريخية ومآسٍ متواصلة، لا يزال موحدًا في أهدافه الوطنية الكبرى: الحرية، والاستقلال، وحق العودة. غير أن هذا التماسك الشعبي لا يجد انعكاسه في البنية السياسية القائمة، التي تعاني من جمود عميق وانفصال متزايد عن القاعدة الشعبية.
لطالما جرى التعامل مع “الوحدة الوطنية” كشعار شامل يُستخدم لتجاوز الأزمات، لكن الإشكالية الأساسية تكمن في سوء تشخيص طبيعة الانقسام. فالانقسام الحقيقي في الحالة الفلسطينية ليس انقسامًا شعبيًا، بل انقسام حزبي وتنظيمي. الشعب الفلسطيني، في الضفة وغزة والقدس والشتات، يشترك في القيم والثوابت الوطنية، بينما تعاني الفصائل والأحزاب من خلافات تتعلق بإدارة السلطة، واستراتيجيات الفعل السياسي والمقاوم، وآليات اتخاذ القرار. الخلط المتعمد أو غير الواعي بين الانقسام الشعبي والانقسام الحزبي أدى إلى تحميل المجتمع مسؤولية أزمة لم يصنعها، وإلى إعفاء البنى السياسية من المساءلة.
في هذا السياق، لم تعد التعددية الحزبية، بصيغتها القائمة، تؤدي وظيفتها الديمقراطية المفترضة. بل على العكس، تحولت إلى عامل إضعاف وتفكيك، وأسهمت في إنتاج نكبات سياسية متتالية دفع الشعب الفلسطيني أثمانها الباهظة. فالتعددية، حين تنفصل عن مرجعية وطنية جامعة، وعن مؤسسات تمثيلية فاعلة، وعن آليات ديمقراطية حقيقية، لا تعود تعددية صحية، بل تتحول إلى صراع صفري بين تنظيمات تتنافس على النفوذ والشرعية، لا على البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
المشكلة هنا ليست في مبدأ التعددية بحد ذاته، بل في سياقها المشوه. فغياب الدولة تحت الاحتلال، وتعطّل الانتخابات، واحتكار القرار السياسي، جعل الأحزاب تتحول من أدوات تمثيل وتنظيم إلى بدائل عن الدولة، تتنازع على الموارد والقرار والشرعية. وبدل أن تكون الفصائل معبرة عن التنوع الاجتماعي والسياسي داخل المجتمع الفلسطيني، أصبحت كيانات مغلقة، جامدة في قياداتها وأدواتها واستراتيجياتها، غير قادرة على التكيف مع المتغيرات اليومية أو الاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين.
هذا الواقع الحزبي المشلول أسهم في نقل مركز الصراع من مواجهة الاحتلال إلى إدارة الخلاف الداخلي. فبدل توجيه الطاقة الشعبية نحو بناء مشروع تحرري متماسك، جرى استنزافها في صراعات داخلية، وفي تبرير الفشل، وفي فرض رؤى سياسية دون تقديم خيارات حقيقية للجمهور. وهنا لم تعد النكبة حدثًا استثنائيًا في التاريخ الفلسطيني، بل مسارًا متكررًا تُعاد إنتاجه سياسيًا، في ظل غياب المحاسبة وانعدام المشاركة الشعبية الفعلية.
من منظور علم السياسة، لا تُقاس جدوى التعددية بعدد الأحزاب، بل بقدرتها على إنتاج سياسات عامة فعالة، وتحقيق الاستقرار، وتمثيل الإرادة الشعبية، وتجديد الشرعيات. وعندما تفشل التعددية في أداء هذه الوظائف، تتحول إلى عبء على المجتمع لا إلى ضمانة له. وهذا ما يعيشه الفلسطينيون اليوم، حيث باتت التعددية الحزبية، بصيغتها الحالية، عائقًا أمام إعادة بناء النظام السياسي، وأمام بلورة برنامج وطني جامع، وأمام توحيد القرار السياسي في مواجهة الاحتلال.
في المقابل، يبقى الشعب الفلسطيني هو العنصر الأكثر ثباتًا في المعادلة. قوته لا تكمن فقط في صموده، بل في وحدته القيمية وفي قدرته الكامنة على المبادرة والتغيير. غير أن هذه القوة ظلت معطلة سياسيًا، محاصرة بين فصائل لا تمثله تمثيلًا حقيقيًا ولا تشركه في صناعة القرار. ومن هنا، تصبح العودة إلى الشعب، لا كشعار بل كمنهج سياسي، المدخل الحقيقي لأي تغيير وطني جاد.
المرحلة الراهنة تتطلب انتقال الشعب من موقع المتفرج إلى موقع الفاعل، عبر المبادرة في بناء أطر سياسية ومدنية جديدة، أو إعادة فرض دوره داخل الأطر القائمة، بما يخلق حالة تنافس حقيقي على تمثيله، ويدفع الأحزاب التقليدية إلى التغيير أو التجاوز. كما تتطلب تفعيل أدوات المساءلة الشعبية، بحيث تُقيّم الفصائل على أساس أدائها ونتائج سياساتها، لا على أساس تاريخها أو خطابها.
التغيير السياسي الوطني لا يمكن أن يتحقق بالشعارات أو الدعوات العامة، بل عبر خطة واضحة وشاملة، تبدأ بإعادة تقييم الفصائل والأحزاب وقياس مدى تمثيلها للشعب، مرورًا بتقوية الفضاء المدني والشبابي بوصفه المحرك الأساسي لأي تحول سياسي، ووضع أجندة وطنية طويلة المدى تشمل البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعيدًا عن الصراعات الحزبية الضيقة.
كما أن استثمار الزمن الفلسطيني بات ضرورة استراتيجية. فكل يوم يمر دون بناء قوة داخلية حقيقية هو يوم مهدور. الاستثمار في التعليم، وتثقيف الشباب، وبناء مشاريع اقتصادية تعزز الصمود، وتفعيل الحملات الإعلامية، واستخدام القانون الدولي والشرعية الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، كلها أدوات تراكمية تعزز الموقف الوطني وتمنح أي استراتيجية مستقبلية مصداقية وقوة.
المرحلة التاريخية الحالية قد تفرض تقليص هيمنة الأحزاب على القرار الوطني، دون إلغاء الاختلاف أو مصادرة التعدد، بل بإخضاعه لإرادة شعبية عامة وبرنامج وطني جامع. المطلوب وحدة وظيفية في القرار والاستراتيجية، لا وحدة شكلية بين تنظيمات متنافسة. فالفصائل يجب أن تعود لتكون أدوات في خدمة الشعب، لا مراكز قرار فوقه.
في المحصلة، يبقى الشعب الفلسطيني هو القاعدة الصلبة لأي مشروع وطني ناجح، والاعتراف بأن الانقسام حزبي لا شعبي هو الخطوة الأولى نحو التغيير الحقيقي. أما دون إعادة بناء العلاقة بين الشعب والنظام السياسي على أساس المشاركة والمساءلة والمبادرة، فستبقى التعددية الحزبية، بصيغتها الراهنة، جزءًا من الأزمة لا جزءًا من الحل، وستظل النكبات السياسية تتكرر، فيما يمتلك الشعب وحده القدرة على كسر هذا المسار وبناء مستقبل وطني قائم على الوعي والقوة الداخلية والاستراتيجية الجامعة.
إن الاستمرار في إدارة المشهد السياسي الفلسطيني بالأدوات ذاتها، والعقليات ذاتها، وبنية التعددية الحزبية ذاتها، لم يعد خطأً تكتيكيًا يمكن احتماله، بل أصبح خطرًا استراتيجيًا على المشروع الوطني برمّته. فالأحزاب التي لا تُحاسَب، ولا تُجدد شرعياتها، ولا تُشرك الشعب في القرار، تتحول من أدوات نضال إلى مراكز تعطيل، مهما كانت شعاراتها أو تاريخها.
اللحظة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من المجاملات السياسية أو إعادة تدوير الأوهام. فالوقت يعمل ضد الشعب الفلسطيني، لا لصالح الفصائل، وكل يوم يُهدر في صراعات داخلية أو قرارات منفصلة عن الإرادة الشعبية هو يوم يُضاف إلى سجل النكبات السياسية التي لم يعد الاحتلال وحده مسؤولًا عنها. إن الإصرار على بقاء التعددية الحزبية بصيغتها الحالية، دون مراجعة أو مساءلة، يعني القبول الضمني باستمرار الانقسام، واستدامة الفشل، وإعادة إنتاج العجز تحت مسميات مختلفة.
لم يعد المطلوب إصلاحًا شكليًا داخل بنى مستهلكة، بل إعادة تأسيس العلاقة بين الشعب والسياسة من جذورها. فإما أن يعود القرار الوطني إلى الشعب بوصفه مصدر الشرعية الوحيد، وإما أن يستمر النظام السياسي في الانفصال عنه حتى يفقد ما تبقى له من معنى وتمثيل. في هذه المعادلة، لا وجود لحلول وسط مريحة، ولا مجال لتأجيل المواجهة مع الواقع.
التاريخ الفلسطيني يثبت أن الشعب كان دائمًا سابقًا لقياداته في الوعي والتضحية، وأن النكبات لم تنشأ من ضعف الإرادة الشعبية، بل من سوء إدارتها سياسيًا. ومن هنا، فإن أي مشروع وطني لا يبدأ من مساءلة الفصائل، وتقليص هيمنتها على القرار، وتحرير الفعل السياسي من احتكارها، هو مشروع محكوم بالفشل مهما كانت نواياه.
الخيار اليوم واضح وحاسم: إما نظام سياسي يعكس إرادة شعب حي وفاعل، أو استمرار واقع حزبي مأزوم لا ينتج إلا مزيدًا من التآكل الداخلي. وما لم تُحسم هذه المعركة لصالح الشعب، فإن الحديث عن وحدة وطنية أو إنقاذ سياسي سيبقى مجرد خطاب للاستهلاك، بينما تتقدم النكبة بصمت وبأدوات محلية هذه المرة.