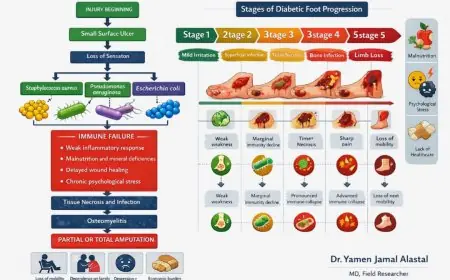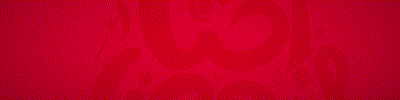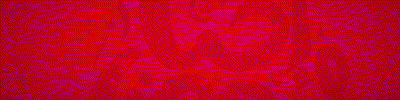لماذا كان علينا أن نُبقي على رؤية واقع غير قائم؟

مروان أميل طوباسي
لطالما كانت فكرة السلام بمسار العمل السياسي حلماً يراود شعبنا الفلسطيني، كما كانت فكرة المقاومة أيضا للوصول إلى ذلك، وذلك من باب الإصرار أو الأمل أو كليهما في الخلاص من واقع القهر والاضطهاد المرير الذي عشناه لعقود طويلة إثر قيام المشروع الاستيطاني الاستعماري في فلسطين. لكن في عمق هذا الحلم، يبرز سؤال جوهري يتبادر إلى الأذهان، وهو لماذا توهمنا أننا قد نصل إلى اتفاق سلام، ونحن نعرف تماماً عقلية بنيامين نتنياهو بل عقلية الحركة الصهيونية منذ جابوتنسكي والمجتمع اليهودي الإسرائيلي القائم والمتدحرج في تطرفه وعنصريته؟
منذ ما فرض علينا من توقيع لاتفاقية أوسلو في عام ١٩٩٣ الذي شابه إدخالنا في نفق غير واضح النهايات إلا بما وصلنا إليه اليوم، أو باعتباره مغامرة، وفق وصف البعض من القيادة الفلسطينية له، في ظل واقع من المتغيرات الدولية والعربية، والذي كان من الممكن أن يشتمل على وضوح أكثر خاصة في موضوع الاستيطان والدولة والاعتراف المتبادل. لقد تَملكَ القيادة الفلسطينية وإن كان هناك اجتهادات مختلفة، القناعة بالمضي في هذا المسار الثنائي، بعد الخروج من مسار مدريد والانتفاضة الكبرى التي كانت قد حققت إنجازات على المستوى الدولي بسلمية مقاومتها الشعبية، والحاضنة الواسعة من شعبنا التي ارتبطت بها. وانتقلت تلك القيادة إلى نوع من التفاؤل شبه المفرط بأن هذه الاتفاقية أي أوسلو، ستكون مفتاحاً لسلام دائم أو خطوة على طريق الدولة، رغم جزيئيات قد تحققت أساسها عودة المؤسسات الفلسطينية وفي المقدمة منها منظمة التحرير إلى أرض الوطن، لكنها كانت وبقيت محاصرة ومكبلة، وعندما حاول المؤسس الشهيد أبو عمار الخروج عنها دُبر له الحصار والاغتيال، وزج بالعديد من القادة الميدانيين، ومن ضمنهم القائد مروان البرغوثي في سجون الأحتلال.
كانت هناك لدى من وقع أوسلو من القيادة آمال كبيرة في أن التحولات السياسية في إسرائيل، والتي لم تتحقق، ستقود إلى قيادة إسرائيلية مستعدة لتحقيق سلام عادل يفضي بنا إلى حل الدولتين. ومع ذلك، وبالنظر إلى تاريخ الصراع والمواقف الإسرائيلية المتعاقبة، يبدو أن هذا التفاؤل كان قائماً على إملاءات أو أمل بواقع لم يكن سقفه أكثر مما عرضه شارون لاحقاً في العام ٢٠٠٥، ما أدى إلى تلاشي مبدأ حل الدولتين اليوم بفعل الإصرار الإسرائيلي على التنكر حتى لذلك الاتفاق، وما تبعه من اتفاقيات أخرى جرت في ظل ميزان قوى منحاز، والبدء بالتوسع الاستيطاني والضم والمصادرة، وصولاً إلى ما يجري حاليا من محاولات تنفيذ خطة الحسم المبكر القائمة على الاقتلاع العرقي والتهجير والإبادة الجماعية في غزة وشمال الضفة حتى اللحظة التي من المنتظر امتدادها.
بنيامين نتنياهو، الذي أصبح رمزاً للسياسة اليمينية المتشددة في إسرائيل، يعبر بوضوح عن عقلية لا ترى في السلام مع شعبنا الفلسطيني خياراً حقيقياً، شأنه شأن الغالبية العظمى من مجتمعهم الاستيطاني، بل هي عقلية تعتمد على السيطرة الكاملة، واستمرار التوسع وتنفيذ الرؤية الصهيونية بل والتوراتية في كل أرض فلسطين التاريخية والإبقاء على التفوق العسكري والأمني والديموغرافي. هذه العقلية لم تكن خافية على أحد، بل كانت واضحة في خطابات نتنياهو وسياساته ومعتقداته التي جاءت أيضا في كتابه "مكان بين الأمم" الذي ما زال يشكل بوصلته في العمل. ومع ذلك، استمرت القيادة الفلسطينية بالمفاوضات في سعيها نحو السلام المفترض برعاية أمريكية وحيدة، ربما بسبب الضغوط الدولية التي ارتبطت بمساعدات مالية ومشاريع غير إنتاجية أو الأمل في حدوث تغيير داخلي في إسرائيل، لكن تلك الضغوط كانت قد أعتمدت على إيجاد حلول اقتصادية وأمنية غير سياسية.
الدعم الدولي حقيقة أم وهم؟
أحد العوامل التي دفعت قيادتنا الفلسطينية وجيلنا وحتى نخبنا الثقافية إلى الاستمرار في هذا الوهم هو الاعتماد المفرط على ما اطلق عليه الدعم الدولي، أو حتى العربي والإسلامي المفترض، وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا. هذا الدعم كان يُنظر إليه على أنه قوة ضاغطة على إسرائيل لتحقيق تسوية سلمية. ولكن في الواقع، كان هذا الدعم يعتمد سياسات النفاق وازدواجية المعايير، ويتذبذب بين تأييد علني منافق للفلسطينيين قائم على سراب الوعود، وسياسات ميدانية تدعم إسرائيل بشكل كامل سياسياً ومالياً وعسكرياً، وفق محددات العلاقة بينهم التي أنشأت أصلاً هذا المشروع الاستعماري كي يستمر ويتقدم، وترفض منذ البداية تنفيذ حقنا في تقرير المصير، وتحصره فقط بما يسمى الشعب اليهودي، ووصول بعض العرب فيه إلى اتفاقيات التطبيع.
كما أن المجتمع الدولي في ظل الهيمنة الأمريكية في قيادة النظام الدولي أحادي القطب، لم ينجح في توفير ضمانات حقيقية أو اتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها وفق القانون الدولي، أو حتى القرارات الأممية الكثيرة. هذا الوضع دفع القيادة الفلسطينية إلى التمسك بأمل غير واقعي في أن الضغط الدولي سيجبر إسرائيل على تقديم تنازلات، بل بالمقابل فان هذا الضغط المرجو تحول إلى ضغوطات على القيادة الفلسطينية.
المجتمع الإسرائيلي شهد تحولات جذرية نحو التطرف خاصة بعد اغتيال الدولة العميقة لرئيس وزرائهم رابين، وصعود التيارات اليمينية الدينية والفاشية بشكل أكثر وضوحاً. هذه التحولات لم تكن خافية، بل كانت واضحة في نتائج الانتخابات وفي التركيبة الحكومية التي تعاقبت على الحكم في إسرائيل. نتنياهو كان في صلب هذه التحولات، حيث استطاع توجيه المجتمع نحو مزيد من التطرف والانغلاق، رافعاً شعار "الأمن أولاً "، ورافضاً لأية تسوية يمكن أن تؤثر على "أمن" إسرائيل وتفوقها، باعتبار أن اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة تشكل تهديداً جوهرياً استراتيجياً عليهم، باقرار كافة الاحزاب الصهيونية في الكنيست الإسرائيلي بذلك.
بعض الفلسطينين في ظل هذه التحولات، قد اخطأوا في تقديرات الموقف الأمريكي الثابت الذي لا يمكن أن ينحاز لقضايا وحقوق شعبنا الفلسطيني لأسباب أولها عقائدية. ولم يدركوا حجم التغيير الحاصل في المجتمع الإسرائيلي، أو ربما فضلوا تجاهله على أمل أن تأتي قيادة إسرائيلية جديدة أكثر اعتدالًا من أمثال غانتس ولبيد اللذين لا يملكان حتى مشروع سياسي لإنهاء الاحتلال والحرب القذرة في غزة، بل هم معنيون فقط بتحقيق صفقة الأسرى حتى لا تتكرر تجربة رون أراد التي أشارت المقاومة إليها في ما نشرته من فيديو ذي تاثير سيكولوجي ناجح ساهم في اتساع مظاهراتهم في شوارع تل أبيب التي تجري باتساع منذ الأمس. لكن هذا التجاهل أو سوء التقدير، كانت له تداعيات خطيرة، حيث أدى إلى إضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي، وجعل من الصعب تحقيق أي تقدم في مسار السلام المفترض على قاعدة وحدة الشعب والأرض والقضية.
الانقسام الداخلي الفلسطيني
أحد أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم الوضع هو الانقسام الداخلي الفلسطيني على إثر الانقلاب في غزة، هذا الانقسام أضعف من قدرة الفلسطينيين على تقديم جبهة موحدة وقوية في مواجهة إسرائيل. فالقيادة الفلسطينية لم تستطع التعامل بفعالية مع هذا الانقسام وإنهائه، مما أدى إلى تآكل الثقة بين مختلف الفصائل، وأثر سلباً على الموقف الفلسطيني الشعبي العام على إثر غياب الانتخابات من جهة أخرى كشكل متقدم لكن ليس وحيداً للديمقراطية والشفافية وفصل السلطات، الأمر الذي أدى إلى وصول مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير كممثل وحيد وشرعي، وصاحبة الولاية والمكانة الدولية إلى حالة من اتساع فجوة هوة علاقاتها بشعبنا من جهة، وإلى الضعف والترهل والاستهداف من جانب الاحتلال من جهة أخرى، ما أتاح للأمريكان والأوروبيون وبعض العرب محاولات فرض ما يسمى بتجديد القيادة الفلسطينية والنظام السياسي، في ظل تأخر هذه القيادة وعدم اكتراثها بما هو مطلوب وطنيا بهذا الخصوص.
الانقسام لم يكن فقط بين الفصائل الفلسطينية، بل امتد إلى صفوف الشعب نفسه، حيث أصبح هناك تباين كبير في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع إسرائيل. هذا التباين أدى إلى تقويض الجهود الرامية إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة قادرة على مواجهة التحديات الإسرائيلية من خلال الإصرار على مبدأ احتكار المعرفة وممانعة الشراكة، وعدم تقبل الرأي الآخر في إطار الوحدة، وإلى وجود ضغوطات خارجية تحول دون ذلك.
لا يمكن الحديث عن التفكير الفلسطيني بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي. الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، وكذلك القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا، كلها لها مصالحها الخاصة في هذا الصراع تسعى إلى تحقيقها. الأردن ومصر يسعيان إلى الحفاظ على استقرار حدودهما مع إسرائيل، وضمان أمنهما القومي واستقرار أوضاعهما ومصالحهما الإقتصادية الأخرى، في حين أن تركيا وإيران تسعيان إلى تعزيز نفوذهما الإقليمي من خلال دعم أطراف فلسطينية، بما يخدم مصالحهما الخاصة ومشاريعهم بالمنطقة، وفق علاقات متفاوتة مع حركة الإخوان المسلمين التي عبثت باستقرار المجتمعات العربية، وتقاطعات مع الولايات المتحدة من جهة أخرى والتي لا تقبل بدولة فلسطينية ذات سيادة.
السعودية بدورها، تلعب دوراً مركزياً في مسار القضية الفلسطينية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في تحقيق توازن بين هذا الدعم وبين تطلعاتها الإقليمية والسياسية في مواجهة إيران، رغم المصالحة التي رعتها الصين بينهما.
هذا التعقيد الإقليمي جعل من الصعب على الفلسطينيين الاعتماد على دعم ثابت ومستقر من جيرانهم، حتى في الشأن المالي وبعدم رغبة هذه الدول في مواجهة سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وتحديداً خطط التطبيع والدخول في مواجهة معها، ما أضاف تحديات جديدة أمام إمكانية تحقيق السلام وفق المبادرة العربية التي أكل نتنياهو وشرب عليها كما الظروف الناشئة.
ربما حان الوقت لإعادة النظر في شمولية التفكير الفلسطيني حيال عملية السلام المفترضة، فالوهم الذي تملك بعض الفلسطينيين بإمكانية التوصل إلى سلام مع إسرائيل وفق قواعد آخذه بالانهيار من جانب، وشكل المقاومة القائم في ظل المعطيات الحالية لمجموعات قد تبدوا غير مترابطة ضمن رؤية متكاملة، لكنها شجاعة وباسلة إلا أنها لن تؤثر بالشكل المفترض على واقع ميزان القوى الذي أشرت له، بما يوفر في الواقع لدولة الاحتلال مساحة لمزاعمها أمام العالم في محاربة "الإرهاب" لكتائب عسكرية مرتبطة بقوى إقليمية في غياب الدعم الرسمي الفلسطيني حتى لفكرتها. هذا الواقع الممتد يجب أن يخضع لمراجعة جادة تخدم صمود شعبنا وبقائه فوق أرضه، كشكل من المقاومة التي هي حق مشروع لكل الشعوب التي تخضع لأي احتلال. كما يجب أن تخضع أيضا تجربة السابع من أكتوبر وما بعدها رغم ما شكلته من هزة وأزمة عصفت بإسرائيل، وتحديداً في نظرياتها الأمنية والسيكولوجية الاجتماعية والاقتصادية، وخلقت تضامناً دولياً شعبياً غير مسبوق لاحقاً مع شعبنا للمراجعة بنفس القدر من أهمية مراجعة مسيرة العمل السياسي منذ أوسلو من جانب آخر ليكون شكل المقاومة وأسلوبها مكلفاً للاحتلال فقط في إطار مقاومة شعبية واسعة ونوعية. يجب أن تكون هناك استراتيجية جديدة موحدة ومتكاملة تتعامل مع الواقع الإسرائيلي والإقليمي بواقعية سياسية تتسم بالوضوح، وتعتمد على تعزيز الوحدة الداخلية، وتحقيق الاستقلالية الوطنية في اتخاذ القرار نحو رؤية وبرنامج كفاحي بعيداً عن التأثيرات الخارجية في هذه المرحلة من التحرر الوطني.
السلام قد يكون حلماً مشروعاً، ولكن لتحقيقه، يجب أن نكون واقعيين ومتمسكين بثوابت حريتنا في فهمنا للتحديات التي نواجهها، ونبني على هذا الفهم استراتيجيات جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافنا الوطنية السياسية. فهل نستطيع التفكير خارج إطار الصندوق لحماية شعبنا والوصول به إلى حقوقه وإنهاء الاحتلال أولاً من خلال وضع الخيارات اللازمة أمامنا ودراستها حتى نحدد التوجهات والأشكال المناسبة للخروج من هذه الحالة التي ينعدم فيها الأفق السياسي وتختلط فيها الأجندات.
...............
الانقسام لم يكن فقط بين الفصائل الفلسطينية، بل امتد إلى صفوف الشعب نفسه، حيث أصبح هناك تباين كبير في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع إسرائيل. هذا التباين أدى إلى تقويض الجهود الرامية إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة قادرة على مواجهة التحديات الإسرائيلية.