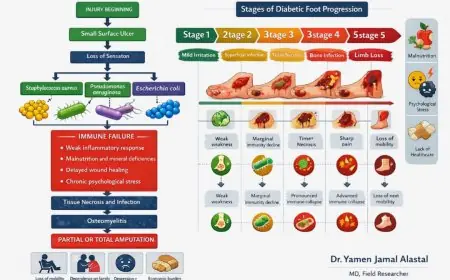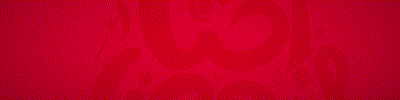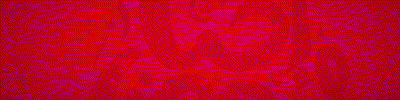حل الدولتين استناداً إلى السابع من تشرين أول صيغة مختلفة

بقلم: برهان السعدي
حرب أكتوبر الفلسطينية حرب مميزة، من حيث قرار الشروع بها وتنفيذها وتبعاتها، انطلقت بقرار جهة فلسطينية مقاومة، دون أخذ إذن من الكل الفصائلي الفلسطيني، المشكل لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو قيادة السلطة الفلسطينية، مما سبب جدلا حول مشروعية قيام فصيل بإعلان حرب بأبعاد تتجاوز الذات الحزبية أو التنظيمية إلى المساس بالمصلحة الوطنية والأمن القومي العربي والتجاذبات الإقليمية والدولية.
جدل لن ينتهي إذا حصرناه بأبعاد ذاتية وحزبية، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي استغلال تبعاتها الميدانية بأبعاد استراتيجية وطنية، حيث لا ينفع البكاء على الحليب المسكوب وفق المثل الإنجليزي.
واقع جديد تشكل منذ الساعات الأولى للسابع من تشرين أول، تمثل بعبور واقتحام لمساحة جغرافية كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1947م، والتي تشكل منطقة هامة وحساسة ببعدها الأمني الحيوي لدولة الاحتلال، والمحمية بأحدث الأنظمة المعلوماتية والوسائل التقنية، والجدر الإسمنتية والشائكة، والمؤسسة الأمنية وقوات جيش الاحتلال التي تشكل أفضل النخب العسكرية في العالم كما يُزعم.
واقع جديد شكل صدمة للمؤسسة العسكرية والأمنية والقيادة السياسية والمجتمع الإسرائيلي برمته، صدمة جعلت القيادة الإسرائيلية تفكر بأنها أمام مخاطر حقيقية تتهدد وجودها، كما كانت صدمة للأنظمة السياسية والقيادات العسكرية والأمنية في الإقليم ودول العالم.
والنتيجة كانت تسارع الولايات المتحدة وغرب أوروبا بتقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري والسياسي والقانوني والإعلامي لردة فعل إسرائيلية قوية من أجل ردع أي تفكير بتكرار مثل هذه الأعمال التي تنال مصالح دولهم الاستعمارية، كونهم هم الذين أنشأوا هذه الدولة بقرار صدّروه للأمم المتحدة عام 1947م، بعد دعمهم للعصابات الصهيونية لاغتصاب وطننا فلسطين، باقترافها جرائم ومجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني من أجل طرده من مدنه وقراه، وما شكلته من مدنيّة في الإقليم لم يكن ما يوازيها من حيث امتلاكها تطورا حضاريا، فقد امتلكت موانئ ومطارات ومكاتب تكسي وشوارع معبدة ومدارس ومعاهد جامعية، وزراعة متطورة، وفرق ونوادي رياضية تشارك في بطولات دولية.
ومجرد قرار اتخذوه بشكل أحادي، دون تنسيق مع صاحب الحق الشرعي في العيش في أرض الآباء والأجداد وبشكل متواصل منذ آلاف السنين، أصبح هناك شعب مهجر ومشرد ومشتت، أفقدوه هويته الوطنية، وفي المقابل نشأت إسرائيل كدولة معترف بها بحكم حق القوة، الذي داس على القيم والحقوق والإنسانية. وبقيت الهوية الفلسطينية مهدورة، والشعب الفلسطيني منقسم وموزع الولاءات بين أحزاب وأنظمة، رأى فيها إمكانية إعادته إلى وطنه السليب. واستمر هذا الحال، إلى أن انطلقت الثورة الفلسطينية ببندقية حافظت على بوصلتها نحو تحرير فلسطين، فاستعادت الهوية الفلسطينية لشعبنا الفلسطيني، وشكلت منظمة التحرير الفلسطيني بوجود مقاومة مسلحة البيت للكل الفلسطيني، فأصبحت المنظمة كينونة سياسية ووطنية للشعب الفلسطيني، رغم وصفها بالإرهاب ووصف مقاتليها بالمخربين.
وبعد العدوان على لبنان في صيف 1982م، ومعركة بيروت الأسطورية، وما تلاها من خروج، ثم الانتفاضة الأولى المجيدة، نتجت مفاهيم سياسية جديدة بفعل حجم النضال والمقاومة، وتشكل مفهوم حل الدولتين، الذي لا بد أن يتحفظ عليه الفلسطينيون، لأن هذا انتقاص من حقوقهم الوطنية، فهو تأكيد على شرعية ووجود إسرائيل كدولة قائمة، ومطالبة الشعب الفلسطيني والأمة العربية بالمناداة بشرعية ووجود إسرائيل كدولة إلى الأبد على الوطن فلسطين، والأصل أن ينادي الإسرائيليون بحل الدولتين، أي بإقامة دولة فلسطينية بجانب دولتهم المقامة قسرا على أرض وطننا، كمحاولة بالضرورة لاسترضائنا، لا أن يشكل تهافتا فلسطينيا وعربيا عليه. وابتلع الفلسطينيون هذا الطعم، الذي أورثهم أوسلو، فبدلا أن تكون أوسلو مدخلا للحقوق الوطنية، شكلت مدخلا للتفريغ من الحقوق الوطنية، كالاستقلال والعودة وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحويل السلطة الفلسطينية الناشئة بفعل أوسلو إلى رافعة لترتيبات أمنية في الإقليم، لمصالح إسرائيلية وأمريكية، تتجاوز مفهوم التنسيق الأمني. وبالتالي، بقي شعار حل الدولتين كطعم يردده الفلسطينيون، دون رصيد قوة، وبالتالي أضحت القضية الفلسطينية وحل الدولتين مدرجا في ملفات تعلوها طبقات غبار، يمكن العودة إليه لضرورات إعلامية أو مصالح آنية في ترتيبات أمنية معادية لقضية فلسطين الوطنية. والمخرج الفلسطيني الرسمي كمحاولة لاستجداء الحقوق، كان التأكيد على ضرورة التفاوض، والمناداة بمقاومة شعبية سلمية، لا تتجاوز الصراخ على حاجز مدجج جنوده بأحدث الأسلحة الرشاشة، والنتيجة محكومة سلفا في موازين القوى، حيث أوراق القوة على الطاولة تفرض وترسم الخارطة الجيو سياسية.
وجاءت فرصة السماء للشعب الفلسطيني والأمة العربية جمعاء، باستغلال الحدث الضخم في السابع من تشرين أول، حيث أظهر قوة الموقف الفلسطيني ميدانيا، مقابل الضعف والعجز الإسرائيلي، سواء لمؤسسته العسكرية أو الأمنية ومنظومته المعلوماتية، واستمر هذا الضعف والعجز الإسرائيلي أياما وهو يحاول إعادة المنطقة المقتحمة إلى سيطرته، ثم قر اره ببدء العدوان على غزة، جوا وبحرا وبرا، فدمر ما يزيد من 75% من البيوت شمالي قطاع غزة، ودمر كل معلم يمكن أن يشكل سببا لوجود حياة للفلسطينيين في المنطقة، واستمرت هجمة الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، فأدرك داعمو العدوان الإسرائيلي على شعبنا، بعد فشل آلة الحرب الإسرائيلية من تحقيق أي هدف ساسي أو عسكري في عدوانهم على غزة، فلا المقاومة هزمت، ولا جنود الاحتلال الأسرى عادوا إلى ذويهم، فأخذ شعار إقامة الدولة الفلسطينية يعود إلى السطح السياسي.
فالولايات المتحدة من خلال إدارة البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومؤسسة الأمن القومي الأمريكي، أخذوا ينادون بصوت عال بأن أمن إسرائيل يتحقق بإقامة دولة فلسطينية، وكذلك أوروبا وبريطانيا.
لكن شعار حل الدولتين الآن، ليس كسابقه في عقود مضت، فالآن أمام الفلسطينيين والعرب ورقة قوة من شقين، هما: انتصارات المقاومة الفلسطينية ميدانيا رغم أسلحتها البدائية، على آلة الحرب الجهنمية والأسلحة الأكثر تطورا وفتكا في العالم، فالمقاومة ما زالت حاضرة في الميدان حسب تصريحات قادة الاحتلال ومؤسستهم العسكرية، وحسب الإعلام العبري، إن تجاوزنا بيانات الناطق الرسمي لكتائب القسام في غزة، أو الناطق باسم حركة حماس في لبنان، أو إعلام الجزيرة، وتصريحات جنرالات الحرب من الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وغيرها.
والشق الثاني من ورقة القوة هو حجم الدمار والكارثة الإنسانية من خلال المجازر والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بقراره السياسي، ومؤسسته العسكرية، والتي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم بحق الإنسانية.
هذا كله، يشكل قوة للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، التي يفترض أن تتوحد فورا، ودون تلكؤ، فالتراخي والتلكؤ في تنفيذ قرار وحدة القيادة، أو وحدة الموقف، بمعنى، إن لم يتم التوصل الآن إلى قيادة موحدة للشعب الفلسطيني، يجب أن تكون شراكة في المواقف السياسية الاستراتيجية، التي يفترض أن تتمحور بوضوح، أن المقاومة في غزة ليست إرهابا، إنما مقاومة شعب ضد الاحتلال، لنيل استقلاله الوطني، وهذا ما يتساوق مع ميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن شيطنتهم لحركة حماس والمقاومة، يخالف وصف الأمم المتحدة التي تعتبرها حركة سياسية.
وبهذا يكون اصطفاف على وحدة الموقف بالمطالبة بتنفيذ الشق الآخر من قرار الأمم المتحدة الذي نفذ العالم نصفه بقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، فالآن يجب تحقيق القرار الأممي والتزام الدول التي أوصت بقرار الدولتين، والذي سمي بقرار التقسيم.
وقوة الموقف السياسي الفلسطيني، لا بد أن تستند إلى شقي ورقة القوة الفلسطينية، أو لنقل ورقتي القوة الفلسطينية، التي لا يمكن تجاهلهما أو تجاوزهما أو إخفاء معالمهما، فالجرم واضح بحق شعبنا الفلسطيني، من قتل ودمار بشكل إبادة جماعية وتهجير قسري، وهذا هو معاداة السامية، فمعاداة السامية لا تكون بشتم يهودي أو تقديم يهودي إلى محكمة وصدور حكم بحقه، إنما بقتل وتدمير وتهجير وظلم الشعب الفلسطيني بجذوره السامية.
وبمختصر وجيز، تشكل هذه المقالة دعوة للقيادة الفلسطينية قبل الذهاب إلى موسكو، لتنفيذ قراراتها وقرار شعبنا بالوحدة، وعليها عدم العودة بخفي حنين، فعلى الأقل، عليهم العودة ببرنامج سياسي موحد، ينصف شعبنا المذبوح في غزة، والذي تلاحقه حراب حثالة البشر من مجرمين وعصابات بقيادة الأشرار أحفاد النازية في الضفة الغربية.
وعلى الإعلام الفلسطيني والعربي والكتاب والمفكرين أن يسيروا أقلامهم ضمن هذه السياقات والآفاق التي عالجتها هذه المقالة.