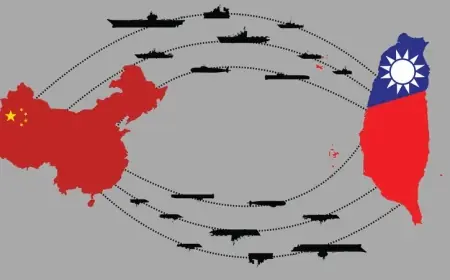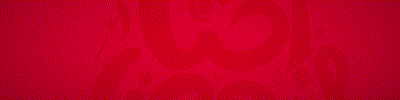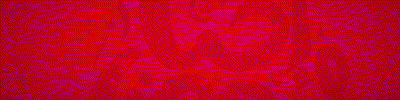هل تكون هدنة غزّة مدخل الحلّ؟
هل تكون هدنة غزّة مدخل الحلّ؟

هل تكون هدنة غزّة مدخل الحلّ؟
تم التوصل إلى هدنة مؤقتة في الحرب الإسرائيلية على غزّة بفضل الوساطة القطرية النشطة ومشاركة مصرية أميركية؛ وهي الحرب التي استمرّت نحو 50 يوماً تحت شعار الانتقام من حركة حماس التي نفذت عملية 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، مع حليفتها حركة الجهاد الإسلامي. وما يُستنتج من المواقف المعلنة، محلياً وإقليميا ودولياً، وجود رغبة عامّة في إطالة أمد هذه الهدنة، وتعزيزها لتكون مدخلاً يؤدّي إلى حلّ سياسي يضع حداً للصراع المزمن المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ منذ وعد بلفور في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 ، مروراً بقرار الأمم المتحدة التقسيم عام 1947، ومن ثم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وضمن هذا السياق، هناك حديثٌ عام نسمعه من مسؤولي غالبية الدول، خصوصا من الأميركان، والغربيين عموما، بالإضافة إلى مسؤولين في عدّة دول عربية، وحتى من مسؤولين في كل من الصين وروسيا بشأن حلّ الدولتين، فهؤلاء يرون ضرورة العودة إلى حلّ الدولتين. وفي مقابل هذا التوافق الدولي على هذا الحلّ، لم تصل القوى الإسرائيلية المتطرفة المشاركة في حكومة نتنياهو بعد إلى مرحلة القناعة التامة بضرورة اعتماده، وهو الذي من شأنه تحاشي انفجار نزاعاتٍ مستقبليةٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أما أن يتم الاستمرار في مصادرة الأراضي، وتكون هناك مواظبة على بناء المستوطنات فوق أراضي الفلسطينيين، والتحرّش بهم، واستفزازهم وإهانتهم بمختلف الأساليب، منها: عدم احترام هويتهم الوطنية، والاعتداء على مقدّساتهم، بل والتشكيك في إنسايتهم، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشجيع واقع الانقسام الفلسطيني، وغير ذلك من خطوات سلبية؛ فهذا فحواه أنه لا توجد نيّة للحلّ، وإنما هناك حرص على تعطيل أيّ حلّ، وإيجاد الذرائع لتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية الإخفاق.
غير أن تأكيد مسؤولية الجانب الإسرائيلي في عهد الحكومات اليمينية المتشدّدة، خصوصا في ظل حكومة نتنياهو الحالية التي تعدّ من أكثر الحكومات تشدّداً وتطرّفاً، ورغبة في دفع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الطريق المسدود؛ ليس معناه إعفاء الجانب الفلسطيني نفسه من قسطه في مسؤولية عملية الإخفاق، فالانقسام بين سلطتين، واحدة تعد في المنظور الدولي السلطة الشرعية تحكم الضفة الغربية من مقرّها في رام الله، والثانية هي التي تمتلك في منظور فلسطينيين كثيرين الشرعية الشعبية، وهي سلطة حركة حماس في قطاع غزّة، ولها امتدادات شعبية وحزبية في الضفة أيضاً. ولكل سلطة منهما علاقاتها الإقليمية المتباينة التي تؤثر على توجّهاتها وتحركاتها، وهي تحصل من خلال هذه العلاقات على أسباب البقاء والاستمرار ضمن الحدود الدنيا. وهناك قوى فلسطينية شعبية غير مشاركة في أيّ منهما؛ وقيادات نشطة، خصوصا في المنظمات المختلفة ومنها حركة فتح نفسها، تركت العمل الرسمي، أو أُبعدت عنه، لعدم قناعتها بسلامة ما يحصل. فهؤلاء قد وجدوا في ميدان العمل الجاد من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الداخل الوطني والمهاجر، وللأجيال المقبلة المجال الذي يجسّد طموحهم وأهدافهم. ولم تتمكن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عبّاس من تجديد نفسها، بل أصبحت أكثر ترهلاً، وأقلّ قدرة على التحرّك واتخاذ المبادرات التي كان من شأنها فتح الآفاق أمام وحدة الموقف الفلسطيني، أو إحداث اختراقات سياسية تدفع باتجاه الحل.
وبذريعة عدم وجود خيارات أمامها، ارتأت حركة حماس الانخراط في "محور المقاومة والممانعة" مع إيران وحزب الله وسلطة آل الأسد والمليشيات العراقية، وهو المحور المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في سورية ولبنان والعراق واليمن. ورغم أنه يُسجل لـ"حماس" عدم مشاركتها في عمليات قتل السوريين وتشريدهم وتدمير مدنهم وبلداتهم، في حين أن الأطراف الأخرى في المحور المذكور فعلت ذلك، إلا أن تموضعها ضمن المحور المعني يصبّ في مصلحة هذا الأخير، من خلال محاولة النظام الإيراني، الذي يقود هذا المحور، التنصّل من تهمة الاستغلال المذهبي لتحقيق مشروعه التوسّع والتمدّد في دول الجوار ومجتمعاته، وتهديدها بالمسيّرات والصواريخ، وإحداث تغييرات بنيوية فيها. كما أن استمرار "حماس" في المحور المعني يُبعدها عن الدول العربية المتضرّرة من سياسات النظام الإيراني وممارساته، الأمر الذي يساهم، بهذه الصيغة أو تلك، في تعميق الشقاق الفلسطيني، ووضع مزيد من العراقيل أمام العمل الفلسطيني المشترك المطلوب، خصوصا ضمن صفوف الشباب وسائر المطالبين بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وما يطرح اليوم مجدّداً بخصوص موضوع حلّ الدولتين، لم يتجاوز بعد حدود التهدئة التسويفية التي تذكّرنا بالحيلة التي كان الفقراء يلجأون إليها لإقناع أطفالهم المطالبين بالملابس الجديدة استعداداً للعيد، إذ كانوا يقولون لهم إنهم وضعوا مساميرها في الماء. مع فارق أساسي يتشخّص في أن الدول التي تقترح حلّ الدولتين، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، تمتلك القدرة على التطبيق إذا أرادت، ولكنها لم تفعل شيئاً، بل كان الحديث عن هذا الحلّ بالنسبة إليها مجرّد وسيلة لتجاهل الممارسات الإسرائيلية التي استهدفت في الواقع العملي تفجير فكرة حلّ الدولتين، وإلغاءها؛ وكان اللجوء، في المقابل، إلى أسلوب التطبيع الثنائي مع الدول العربية، الأمر الذي ثبت فشله بعد كل ما حصل، وقد يحصل، في غزّة أو غيرها. وتبيّن بوضوح أن التطبيع مع الحكومات من دون الشعوب لن يحقّق استقراراً، ولا أمناً، ولا سلاماً، فقد ظهر جلياً أن موضوع التطبيع الثنائي مع عدة دول عربية كان مجرّد تغطية للممارسات الإسرائيلية التي استهدفت، في الواقع العملي، تفجير فكرة حلّ الدولتين، وتجاوزها نهائياً، والتفكير في فكرة تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وحتى أبعد من دول الجوار.
ينبغي أن يكون التطبيع الحقيقي المجدي في الحالة الإسرائيلية الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني في الداخل، من خلال احترام خصوصية هذا الشعب وحقوقه، واعتماد الشكل الإداري المناسب لحل المشكلات، ووضع حد للانسدادات والاحتقانات، وتراكم الأحقاد. ومثل هذا التطبيع الداخلي لا يمكن في غياب شخصيات قيادية كاريزماتية في الجانبين تثق بذاتها، ويثق بها الناس. شخصيات تؤمن بضرورة التوصل إلى حل سلمي متوازن مستدام لمصلحة الجميع؛ وتكون مستعدّة لتحمّل النتائج. أما القيادات المتهمة بالفساد، أو التي تعاني من الضعف، أو المرتبطة بالمشاريع العابرة للحدود، فهي غير قادرة على التصدّي لهذه المهمّة بالغة الصعوبة والمعقدة جداً.
لقد أعادت الحرب الإسرائيلية على غزّة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأحدثت هزّة عميقة في العلاقات الدولية، ووضعت الحكومات الغربية في مواجهاتٍ صارخةٍ مع شعوبها التي خرجت منها جموع كبيرة في مظاهرات واعتصامات وفعاليات كبرى، لتُعلن عدم اقتناعها بمواقف دولها التي امتنعت حتى عن رفع الصوت، والمطالبة بوقف قصف المدنيين، سيما الأطفال والنساء والمسنّين والمرضى الذين أصبحوا ضحايا عملية عقاب جماعي متوحّش رداً على عملية طوفان الأقصى.
وكشفت الحرب بوضوح حقيقة هشاشة النظام العربي الرسمي، وعجزه عن اتخاذ القرارات والمواقف الحاسمة التي كان من شأنها إضفاء قسط من التوازن على المعادلات المختلّة. وستكون مرحلة ما بعد الحرب أقسى وأشدّ ما لم تكن هناك خطوات جادّة على طريق الحلّ، ولكن هذه الخطوات لن تتمكّن من شقّ طريقها في ظل الواقع الحالي للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة حماس. فعلى الصعيد الإسرائيلي، هناك حاجة أكيدة لظهور قيادة معتدلة، ترى في موضوع الحلّ حاجة إسرائيلية، على عكس ما يعتمده راهناً نتنياهو الذي يرى في دفع الأمور نحو مزيد من التعقيد والتصعيد فرصة للبقاء والتهرّب من الاستحقاقات. وعلى الجانب الفلسطيني بشقّيه، السلطة الوطنية و"حماس"، هناك حاجة ماسّة إلى عمل جادّ للتوصل إلى وحدة الموقف، والتركيز على الأولويات الفلسطينيّة، وبالتنسيق مع الدول العربية التي تظلّ العمق الحيوي الاستراتيجي للشعب، وتقطع الطرق أمام اتخاذ القضية الفلسطينية أداة دعائية في مشاريع "محور المقاومة" التوسعية.
تتمثل الخطوة التالية في ضرورة عقد مؤتمر دولي إقليمي، هدفه التوصل إلى حلّ واقعي مقبول دائم، على أساس احترام الحقوق، للنزاع، واعتماد آليات واضحة، واتّخاذ خطوات ملموسة، تنفّذ ضمن مواعيد محددة لا تحتمل التسويف. وبطبيعة الحال، تبقى الولايات المتحدة القوة الأكثر قدرة على الدفع بهذا الاتجاه، بحكم قدرتها على التأثير في الموقف الإسرائيلي إذا أرادت، إلى جانب علاقاتها الجيدة مع دول الخليج ومصر والأردن والدول الإقليمية صاحبة الوزن، وينبغي أن يكون ذلك كله بالتنسيق والعمل المشترك مع الأوروبيين والقوى الدولية المؤثرة في هذا الملف. أما الاكتفاء بالدعوة إلى حلّ الدولتين من دون توفير الشروط الواقعية المطلوبة لتحقيقه، فهذا فحواه أننا لم نتجاوز بعد دائرة الوعود التخديرية التي لن تحقّق الأمن والاستقرار، ولن تؤدّي إلى السلام، بل سيكون هناك مزيد من الاضطراب الممهد لمزيدٍ من الحروب. وهنا قد يكون من المناسب أن نستعير من الإخوة المصريين عبارة "في المشمش"، للتعليق على مقترح يفتقر إلى مقوّمات القبول والتطبيق. عن "العربي الجديد"